


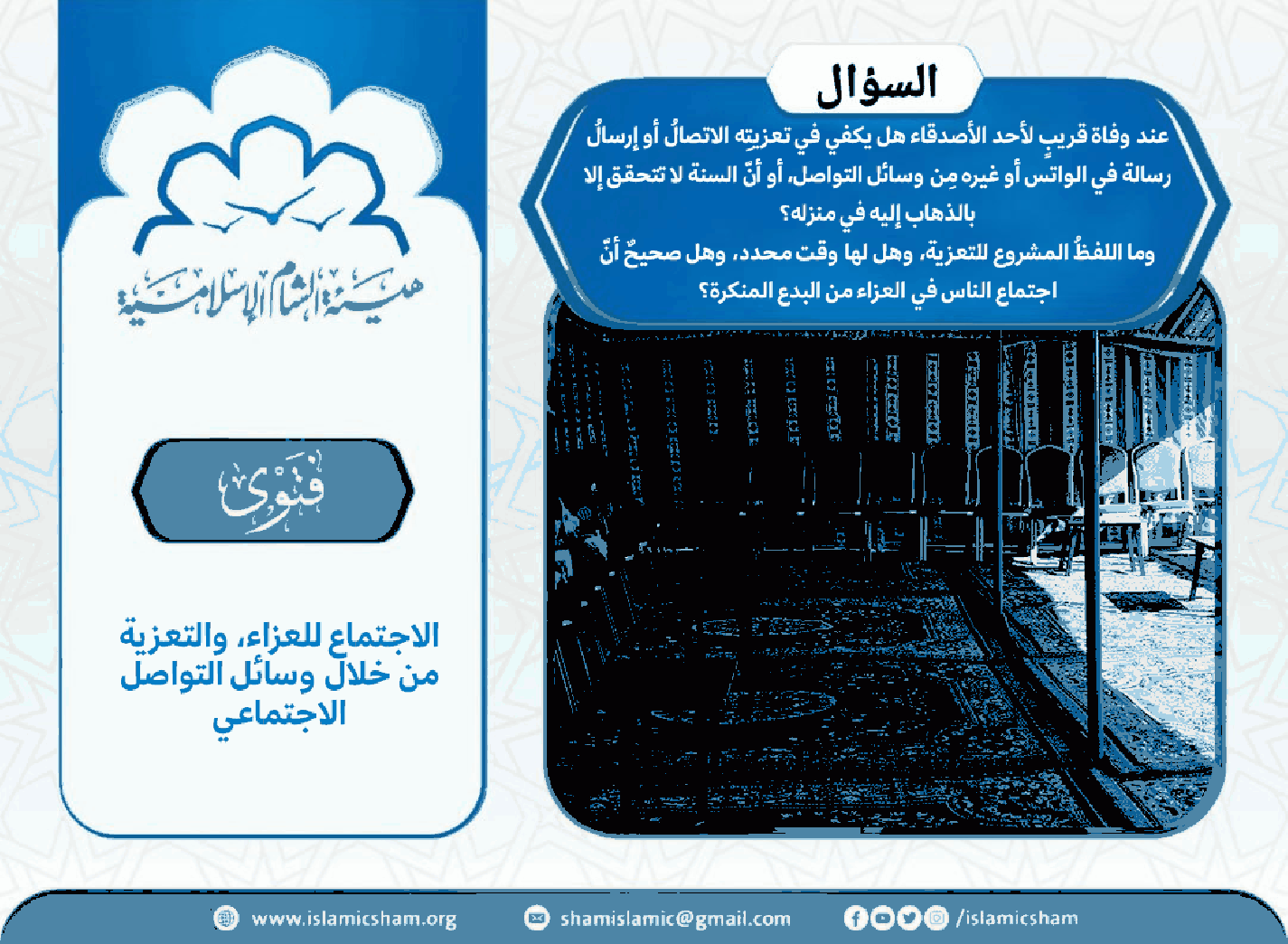





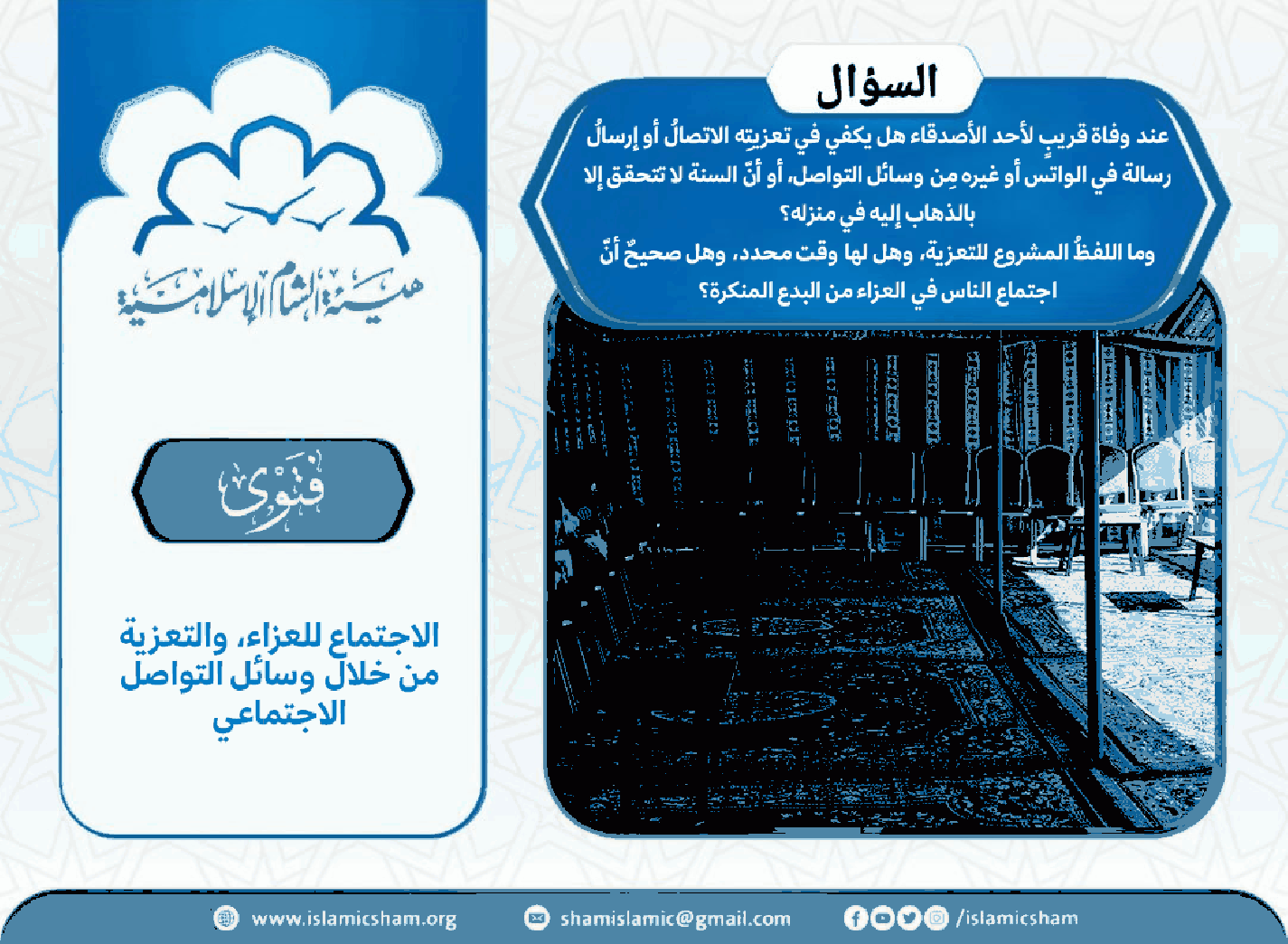


الثورة العربية للقرن الخامس عشر الهجري بحالاتها المختلفة تختصر لنا كل أنواع محاولات التغيير لدرجة أنها أصبحت مرجعية بنفسها لدراسة طبيعةِ فعلِ الثورة في القرن الحادي والعشرين. والذي يهمّني تحديداً هو عمليات الإنضاج السريع بعد قرن ضائعٍ في تاريخ البلدان العربية.
قلت الثورة العربية بالإفراد للتأكيد على الاتحاد في جذرها. فبدايات القرن العشرين كانت سنين الحرب العالمية التي نتج عنها توزيع مناطق النفوذ بين القوى التي صعدت عالمياً وتمكّنت من قبلُ فيما يُسمى مرحلة الاستعمار وعلوّ المشروع الأوربي وتصفية الحسابات البينية، تلك الحسابات التي تظل في حالة شدٍ وجذب مستمر فيما بين القوى المسيطرة. وما يسمى العالم الثالث هي البلدان التي انتُهبت ثرواتها وتمّ تفكيك مؤسساتها التقليدية وتمّ إخضاعها إلى علاقات تبعية. ثم حصلت على استقلالها الرسمي الذي نادراً ما غيّر العلاقات الاستغلالية على الصعيد الاقتصادي. أما على الصعيد السياسي فقد تحصّلت لهذه الدول مساحة تحرّكٍ ما. وفي الحالة العربية أتى ذلك على نحوين: بلاد حكمتها نخبٌ تربّت على فكر الاستعمار وهي معجبة بطرقه وثقافته ووسائله، تريد استنساخه واستنساخ تجربته وسلخ المحلي التقليدي… وبلاد حافظت على قدرٍ من الموروث وغطّت نفسها بقشرة من شرعية الماضي وفق نمطٍ نفاقي محض.
الحكومات الجديدة هي (وطنية)، ولكنها في حقيقتها هي (1) نخبوية تتباعد عن نبض عامة الشعب؛ (2) وتتنكر للتاريخ الحضاري للمنطقة؛ (3) وتبشّر بأنماطٍ حداثية هي نسخة مكررة -ومنسوخة نسخاً سيئاً- عن التجربة الأوربية. لقد كاد أن يصل تشويه مصطلح “الوطني” إلى غطاء لانسلاخ ثلاثي عن تاريخنا وعن جغرافيتنا وعن مصدر إلهامنا. وهذه هي موجبات التغيير.
وكان هذا هو مبرر تسميتها الثورة العربية بالإفراد، فتصميم بلاد ما بعد (الاستقلال) تصميم مفروض من الخارج، وتعرّضت البلدان إما إلى تجزيء وتمزيق، أو إلى رسم حدود إما اعتباطية لا تتطابق مع حقيقة الواقع، أو إلى تشييد جدران عداواتٍ لا داعي لها لا من ناحية التاريخ ولا من ناحية الثقافة. المثال النموذجي هنا هو الجزائر والمغرب حيث أن كلتيهما كانتا تحت النفوذ الفرنسي و(خرجت) فرنسا بعد أن وضعت هاتين البلدين في وضعية عدائية يصعب تبريرها.
والنخب الحاكمة نخب مستغربة وتعيش حالة اغتراب، فهي مستغربة في عزمها على تقليد الغرب وهي في حالة اغتراب عمن تحكمه، وأشد هذه الحالات في بلاد الشام حيث تمّ تمكين أقلياتٍ تعيش حالة توتّر هويةٍ عالٍ وعندها نقمة ليس تجاه جمهور الشعب فحسب بل وأيضاً تاريخه.
وبشكل عام، يمكن تصوير الوضع في فترة ما بعد الاستعمار المباشر بأن الصعيد السياسي هو الأداة الإدارية للسيطرة الخارجية، والصعيد الاقتصادي هو الأداة العملية لهذه السيطرة.
نعم، حكومات ما بعد الاستقلال كان فيها قدر من الوطنية والاستقلالية، وقوى الهيمنة الخارجية تعالج ذلك من خلال الانقلابات والمكايدة الإقليمية. وكذا المحاولات الاستقلالية للاقتصاد وتقديم مصلحة البلد يجري معالجتها من خلال ضغوط دولية ناهيك عن العقود المبرمة مسبقاً وتصميم العلاقات لتعميق الاعتمادية على الآخر. المقاومة على الصعيد السياسي والاقتصادي وُجدت إلى حدٍ ما، ولكن هي محدودة بحكم التفاوت الشاسع في القوى بعد التجزئة والعداء البيني العربي-العربي.
وبقي التحدي الأكبر في الصعيدين الاجتماعي والثقافي. وهو تحدّي لأن الاجتماعي صعب الاقتلاع ولأن الثقافي بطيء التغيير.
المقاومة الأعمق هي على الصعيد الاجتماعي والثقافي بسبب طبيعة هذين الحقلين. فمثلاً، على الصعيد الاجتماعي هناك نسق الأسرة الراسخ، وخلخلتها تحتاج مرور زمنٍ لتأزيم نظام العائلة سواء من ناحية إعجاز الرجل عن الإعالة أو من ناحية تشرّب خطاب يمجّد النشوز الأسري.
التغيير على الصعيد الثقافي هو طويل الأمد أيضاً، والجهود المبذولة في التغريب والعَلمنة مشهورة منذ نهايات الفترة العثمانية. وإلى اليوم نشهد خليطاً مربكاً لمثل هذه الجهود تدّعي القيام بالمراجعات والتجديد وإعادة النظر في التراث، مغلّفة بعبارات التقدّم والانفتاح…
كان كل ما سبق مبرر تسميتها ثورة عربية باللفظ المفرد، فهي ثورات متّحدة في أسباب قيامها ومتّحدة فيما تبغيه من رفض القمع السياسي والتطلّع نحو الحرية والكرامة، والرغبة في بناء مستحدثٍ هو من مادة العصر ولكنه منسجم مع النفس الثقافية والخلفية الحضارية.
وهنا يرد الاعتراض على اعتبارها ثوراتٍ برغم غياب الصورة المتبلورة للبديل. ولكن تحديداً لأن التغيير الذي ابتغته هذه الثورة هو تغيير شديد الشمول، فإن ذلك برّر وصف الثورة. غير أنه لا مراء أنه في النهاية لا بدّ من تبلور رؤية عملية. جهود الإزاحة تنوّعت بين البلدان العربية بحسب طبيعة النظام القائم، لكن لا يمكن أن يفوت المراقب حالة الوجد الضميري المشترك بين هذه الثورات، وكأن الثورة في بقعةٍ تحكي لأختها عن الهموم والآلام والآمال ذاتها لجيران الأرض والتاريخ. وهذا بنفسه هو نضوج وفتح ثوري.
الانطباع عن الديمقراطية هو كذا انطباع أشبه بالأحلام، ساهم في تشكيله الخطاب الوعظي للأكاديميين كما ساهم فيه إعلام التسلية السياسية في وصف الآخر.
هي ديمقراطية جاهزة تأتي بشكل بسيط: صنّع صناديق لها شبابيك ودع الناس يُلقون فيها بطاقات الاقتراع. وهذه الديمقراطية تحقّق أماني كل فئات الشعب، أقلياتهم وأكثرياتهم إضافة إلى أصحاب الاهتمامات الخاصة. وإذا لم يعجب مجموعة من الناس شيئاً فما عليهم إلا التظاهر وما على الحكومة إلا الانحناء للمطالب.
والتنمية والرخاء يتبعان بشكل أوتوماتيكي. والذي يجري انتخابه عليه أن يكذب على الناس ويدلّس. عليه أن يقول لهم إن العيش الرغيد يقبع خلف ستار مرصّع بعبارات الديمقراطية، وما عليكم إلا انتخابي. وهذا ما على الرئيس المنتخب بعد (نجاح) الثورة أن يقوله، وكأن الأمية ليس لها دخل في تحقق الديمقراطية، ولا البيروقراطية المتورّمة، ولا جيش يقامر بالاقتصاد، ولا أجهزة استخباراتٍ جُبلت على سلوك المافيات، ولا شرطة دأبها الاستقواء على الضعيف، ولا قضاء يُبدع في شرعنة الفساد، ولا إعلامٍ همّه خلط الأذهان وتزوير الحقيقة، ولا حيتان مالّية تُنشئ مستوطناتٍ داخل البلد تُمرّغ كرامة الحمقى الذين لم يستطيعوا تحصيل نمط حياة البزخ والتكبّر.
وهذه الديمقراطية المستوردة هي مسبقة الصنع وجاهزة للتشغيل تنتظر كبسة الزر. فلا على النخب تفصيل ما يناسب البلد ويوافق ثقافة الشعب وتاريخه، ولا على الناس الانخراط في سجال سياسي عاقل ينحّي الإيديولوجيات الدينية والعَلمانية على حدٍّ سواء، تلك الإيديولوجيات التي توهم أن هناك أجوبة جاهزة في الكتب القديمة ذات الورق الأصفر أو الكتب الحديثة ذات الورق الأبيض.
الفهم العملي لما تعنيه الممارسة السياسية هو فتح من الفتوحات الثورية.
سلامة صدرِ الجموع توازيها سذاجةُ فهمِ النخب السياسية التي تعتبر نفسها ممثّلاً عن الثورة أو متكلّماً باسمها. فهي تفترض أن حضرة النظام العالمي ديمقراطي ليبرالي، وتحسب أنه إذا تحلّت بالشارات الديمقراطية وراعت الحساسيّات الليبرالية فسوف يتقبّلها العالم، فيجري الانضمام بشكل سلسٍ إلى نادي العالم المتقدّم. و “ديمقراطيا” الحلوة هذه ملزمةٌ بقبولي وسوف نعقد أذرعنا معاً ونتمشّى على سواحل الرقيّ نلحس الآيس كريم التي في أيدينا لترطيب الأجواء.
وجالياتنا في البلدان الغربية تريد أن تُقنع نفسها أنها ليبرالية وأنها تفهم اللعبة الديمقراطية وتوهِم نفسها بأنها تخدم القضية من خلال دعم هذا النائب أو ذاك، ومن خلال (حكّ الأكتاف) مع المسؤولين في تلك البلاد، إلى جانب بذل سخيّ التبرعات السياسية التي يحسبون أنها تشتري القرار.
الصدمات أيقظت الحسّ الخادر فانتشر الحديث عن الجيوسياسة، وبرغم أن هناك مَن ما زال يخلطه مع محض (المصالح)، إلا أن وعياً جديداً يتشكّل في أنّ الدول الناضجة لها أولويات كبرى ولا تؤثر في سياساتها قضايا حقوق الإنسان إلا في تنميق الخطاب والقلق المستمر من الانتهاكات. وبالتالي فإنه لا يفلّ حديد الجيوسياسة إلا حديد الواقع التحرّري الصابر طويل النفس.
تطور هذا الوعي هو من الفتوحات الثورية.
ليس ثمة شيء جديد في مراوغات احتواء الحركات الوطنية في بلادنا العربية، فهو قديم قدم تأسيسها. وإذا كانت الثقة بدول لافتات الاعتدال أمراً يحتمل النقاش في منتصف القرن العشرين، أصبح منذ نهاية ذاك القرن مورد الهلاك المتدرّج الذي تقوم به الجماعاتُ نفسُها اختياراً. الإيديولوجية هي نفسها، والمبررات نفسها، والغفلة هي الوحيدة التي ربت وتضخّمت. فهل نعزو ذلك إلى ردّة الفعل تجاه العنف العدمي. وأوليس من مآسي الدهر أن تكون منصات الاحتواء ومنصات تصدير العنف العدمي هي نفسها. أم نعزو ذلك إلى فقه الموازنات الذي جُعل منه فقه تبريرٍ واعتذارية. أم نعزو ذلك إلى الترهّل المؤسسي للحركات التي تُمكّن أفراداً من القيام بأدوارٍ تتصادم مع منطلقات هذه الحركات. أم هو حبّ الدنيا وكراهية المصابرة. أم هي مجرّد سلامة صدرٍ سياسية في غير محلّها. أم هي إغراءات الحلول السهلة.
أياً كان فإن الإدراك العام بأن الاعتدال (المتحيّز المراوغ) غير شافٍ عندما تُنتهك الكرامة ويُعتدى على الحريات المفطورة هو من الفتوحات الثورية.
الحكمة الباردة والعمل الدائب
البسالة والعزم والتصميم التي أظهرتها الثورات العربية تشهد على حيوية تلك الشعوب… إنها تصرخ في وجه أي شاكٍّ ومعتدٍ بأني موجودة رغم كل التهميش، وأني قادرة رغم كلّ الإضعاف، وأن بديهتي صاحية رغم كل التخدير.
ولكن يعود شيطان الشك فيتسرّب من خلال وسوسةٍ مفادها أن التضحيات لم تتمخّض في نتيجة ملموسة، وهنا ينقسم الناس إلى فئاتٍ مختلفة (وسوف لا أدخل في الحسبان من يصطفون مع الطغيان).
فهناك مَن دوّخهم خلط الأوراق حتى لم يعودوا يثقون بأي شيء، فيستسلمون للحال الواقع كأفضل خيارٍ تستطيع عيونهم رؤيته بعدما أصاب الرأسَ الدوار.
وهناك من يطرح معقولية القبول بالحال الراهن من خلال تحليل أشبه بالسياسي. ومفاد هذا الموقف أن البديل سوف يكون من أصحاب النفوذ الذين يعادون النظام القائم ويوظّفون الحراك لصالحهم. توظيف نتاج الحركة أمر خطير ينبغي ألا يغيب عن الذهن، لكن المرفوض هو اتخاذه تبريراً لعدم التفكير في التغيير أصلاً، لا وجوب الحذر من الاحتواء، الأمر الذي يدعو إلى تعديل الإستراتيجية وإدراك طبيعة المراحل.
وهناك العاكفون على كتب التراث يسيئون فهمه وتنزيله. فتارة يقولون إن مقاومة الصائل جائزة، وتارة يقولون إن لمصلحة حفظ النفوس والممتلكات أولوية. والحراك الثوري كان واعياً أن مسألة عنف الأنظمة المخابراتية ليست مسألة صيال، فالصائل فردٌ معتدٍ، أما الوضع اليوم فهو طغيانٌ مُمأسسٌ ذو طبيعة عالمية. كما أنها ليست مسألة أولويات، فإزهاق النفوس والممتلكات قائم على قدم وساق، وتأجيل معالجة السرطان لا يوقف التكاثر الـمَرَضي للخلايا الفاسدة. هم ليسوا ضدّ ما تريده همم التغيير بقدر ما هو خوف من المجهول وعجز عن فهم الواقع وإدارته.
وبعيداً عن الأفهام المتعجلة في التغيير، وبعيداً عن الحكمة الباردة التي تنتهي في التخذيل والركون، يتشكل اليوم وعيٌ في أن طريق الإصلاح طويل، وأن مسالكه متعدّدة، وأن التعذّر بسطوة الحكم القاهر يزيده قهراً وعدواناً وظلماً. وهذا أيضاً من الفتوحات الثورية.
مثّلت مختلف محاولات التغيير في الثورات العربية مِخبراً لفحص مقولات السلمية والعنف. وابتداء ينبغي إدراك أن الوسائل المتّبعة كانت في حقيقتها استجابة عفوية للواقع أكثر من كونها مواقف نظرية. كل تجارب التحرّر في البلدان العربية كانت سلمية في مبتدئها، ولكن استعمل العنف بدرجاتٍ بعد ذلك.
تجربة تونس كانت سلمية محضة ونجحت في إزاحة السلطة الحاكمة قبل أن تستطيع قوات الشرطة استعادة زمام الأمور، والجيش -المهمّش أصلاً- بقي على الحياد.
الحراك السلمي في مصر سرعان ما واجه تصاعد القمع، ولكن الوضع العالمي للبلد والفاعليات الداخلية الطامعة باقتناص السلطة سارعت في إزاحة رأس السلطة لتفضي إلى مخاض سياسي ليس من السهل أبداً وقوفه على رجليه بسبب الدولة العميقة المتربصة التي سرعان ما عادت وانقضّت وقلبت المحجن.
في ليبيا الحراك بدأ سلمياً وكان مرشّحاً لإضافة طبقة عنفٍ عليه بسبب طبيعة النظام القائم وبسبب طبيعة توزّع أصقاع البلاد التي تبرّر درجة أكبر من الاستقلالية الذاتية والتي يصاحبها حكماً درجة من استحضار القوة. دخول القوى الدولية جواً هو عنفٌ بامتياز وإن كان عنفاً مشرعناً، وكان لا بدّ أن يوازيه على الأرض عمل مسلّح. العنف نجح في الحالة الليبية ومشى مزامناً لتشكيل مجلسٍ انتقاليٍ حظي أخيراً بدرجة من القبول الدولي. ولكن الأمور تغيّرت بعدما تدخلّت جهاتٌ عربية وبعدما حصلت الانتكاسة المصرية. وهذا بدوره غيّر فرص التعافي التدريجي في تونس وعكس جهة السكّة لتقوم بنقض الإنجاز تدريجياً. أي أن محدودية نجاعة التغيير السلمي المحمود واجهت فيما بعدُ فاعليات تآكلٍ نتيجة التغيرات الإقليمية.
اليمن المليئة بالسلاح لم تستعمل السلاح، وقبلت بحلولٍ هي دون المثالية، إلى أن اختطفت البلدَ فاعلياتٌ إقليمية من الطرفين العربي والإيراني.
سورية بدأ حراكها سلميّاً وإن كانت طبيعة النظام القائم -مثل ليبيا- تؤهل إضافة طبقةٍ من العنف. وفعلاً، كان اعتداء النظام على الحُرمات الشخصية وعلى الحُرمات الرمزية (قصف المآذن وتدنيس نسخ القرآن) داعياً لاستخدام القوة للحماية، وكان هذا هو مبرر التسلّح في أول الأمر. ثم ما لبثت الفاعليات الإقليمية أن زجّت السلاح وإيديولوجيات العنف وأصحابها إلى وسط المشهد السوري.
حراك الجزائر السلمي في بلدٍ ما زال يتذكر العشرية الدامية يصعب تصوّر وقوفه عند حدّ التغيير الطفيف على السطح، ويغلب أن ثمة حراكاً سوف يستمر على المستوى المتوسط، واللجوء للعنف مستبعدٌ جداً واستيراد جماعات العنف من الخارج لن يفلح على الأرجح.
إذاً يبدو أن المفرق في الأمر ليس هو العنف الثوري بذاته بقدر ما هو طبيعته ودرجته وكيفية تناوله. والعنف أنواع، أدناه العنف السلبيّ ويتدرّج ليصل إلى العنف الوسيلي المنضبط. ومقابل هذا هناك العنف للعنف… العنف الانتقامي والعنف المبرّر غيبياً والعنف العدمي، وكل ذلك خطيرٌ عملياً ومرفوضٌ أخلاقياً. كما أنه ليس ثمة حاجة للتأكيد على أن من أسوأ أنواع العنف هو ذاك الذي يرتهن لأجنداتٍ خارجية.
ولم يكن قرار استخدام وسائل العنف قراراً واعياً كجزء من إستراتيجية بقدر ما كان استجابة عفوية للواقع. وتبرير هذا أخلاقياً لا يجعله أمراً صائباً من ناحية عملية ولا يغني عن إستراتيجية واضحة.
زيادة الوعي في مسألة العنف والبعد عن كلٍ من الطوباوية والمكيافلية فتح ثوري معتبر.
بالقدر الذي نعي انتهاء المشروع العربي الذي طُرح في القرن الماضي بقدر ما يؤهلنا ذلك لمعالجة الواقع معالجةً تضع القدم على أول الطريق. والمقصود بالمشروع العربي هنا هو الحلم العتيق بتنميةٍ وطنية وسيرٍ تدريجي نحو العلا.
لم يبقَ خيار غير خيار التغيير الجذري، ولهذا قامت الثورات، ولم يبطل الخيار حتى ولو تصل الثورات إلى مبتغاها في المرحلة الأولى. فالتغيير ممتنعٌ بغياب فقهٍ للواقع الداخلي، ومتعذّرٌ بغياب إدراكٍ للبيئة الإقليمية وللوضع العالمي.
ما حدث هو جزءٌ من المخاض، وعمليات النضوج المتسارعة واعدةٌ، والأنظمة المعتلّة هي في وضع أسوأ وأقل تمكّناً مما كانت عليه، واستراحة الإرهاق الثوري تتخمّر في أخاديد تجربتها وعياً متوازناً بين العملية والمثالية، والتراصّ الجغرافي الثقافي لحركات التغيير في البلدان العربية هو مصدر قوةٍ وبشرٍ للمستقبل.