


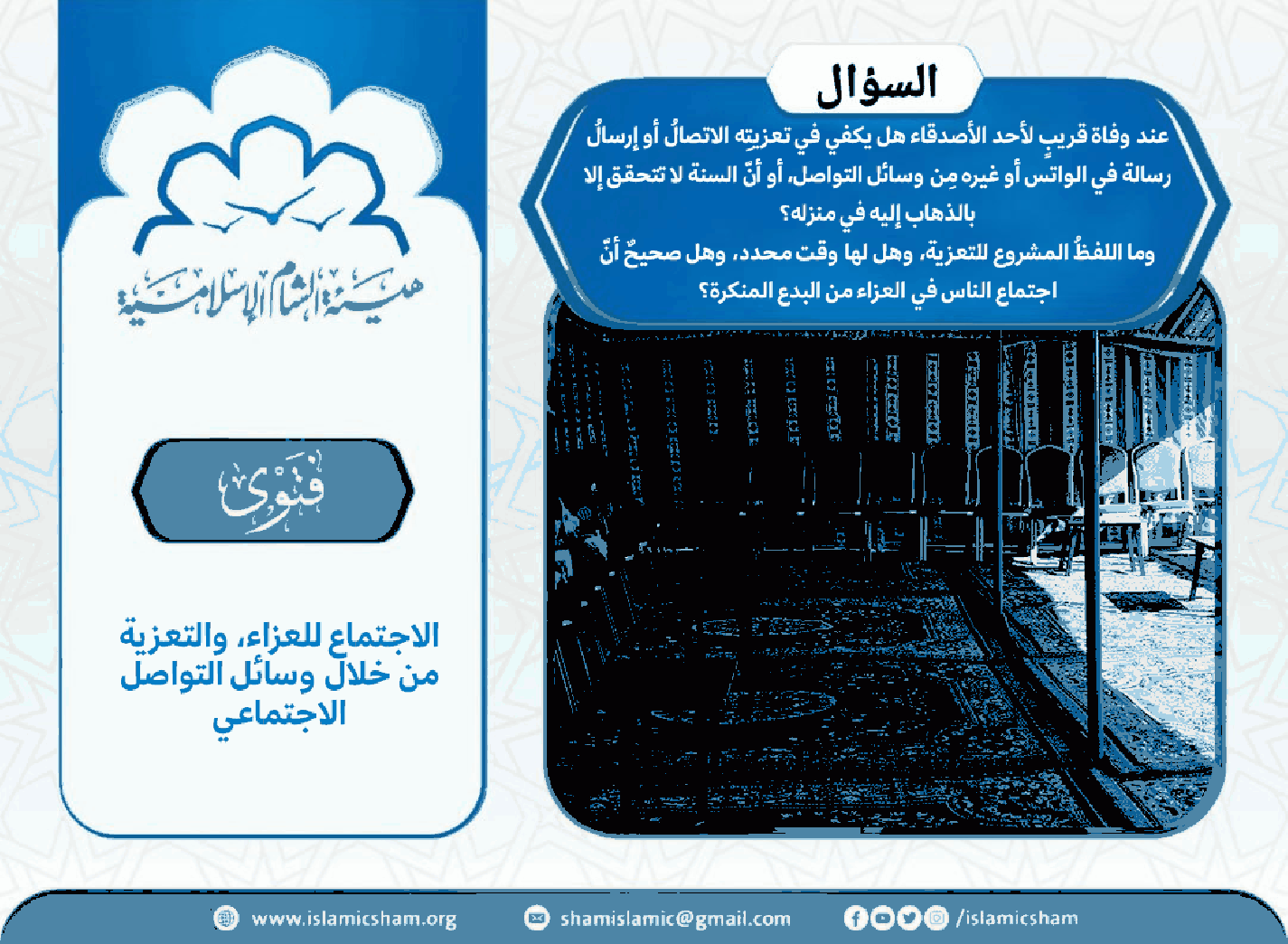





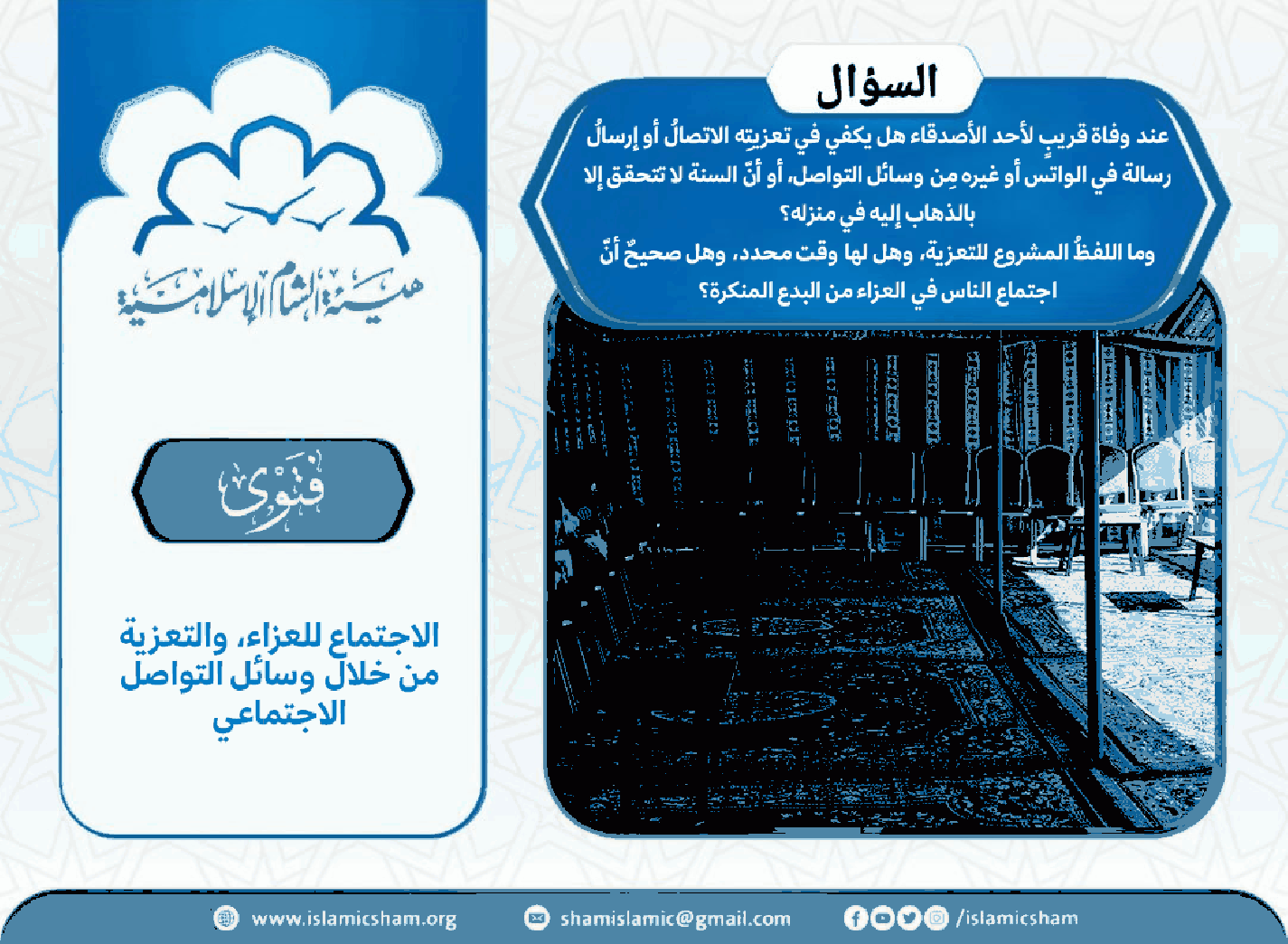


عودة جيل الصحابة الأوائل.. هل ممكن؟!
كلما قرأت عن حياة أحد الصحابة في زمن الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، زادت حيرتي ودهشتي، بل وإعجابي أيضًا بهؤلاء العظماء الذين تخرجوا في مدرسة المعلم والمربي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما قرأت عن حياتهم في الجاهلية وقارنتها بحياتهم بعد الإسلام، لاحظت البون الشاسع بين ما كانوا فيه وما أصبحوا عليه، كيف تغيرت حالهم من أشخاص ذوي قدرات هائلة يهدرونها في سبيل إرضاء أهوائهم إلى أشخاص ذوي قدرات وإمكانيات سخروها في خدمة دين الله وإعلاء كلمته.
كلُّ شخصيةٍ من بينهم، بصراعاتها وترددها وثباتها وجهادها، تشبهنا إلى درجةٍ تمكننا من القول بأن الزمن يعيد نفسه..
فنرى أنفسنا حينًا في شخصية عمر بن الخطاب، في غيرته وتمسكه القوي بالإسلام وشدته على من يحاول أن يخالف أمرًا ولو كان صغيرًا لله أو لرسوله.. وحينًا أخرى نرى أنفسنا في شخصية أبي بكر الصديق، في لينه ورأفته على الضعفاء والمساكين، في هدوئه وثباته وسداد رأيه..
أحيانًا نرى أنفسنا في شخصية سلمان الفارسي التائه والحائر، الباحث عن الحقيقة التي تطمئن قلبه، ولو اضطر إلى سبر أغوار العالم كلها..
وأحيانًا أخرى نرى أنفسنا في شخصية بلال الحبشي، الصحابي الذي كان يؤمن بأن حريته تتحقق عندما يعبد الأحَد ويضحي بنفسه في سبيله ولو كلّفه الأمر حياته، فما معنى لحياته إن لم تكن خالصةً لله.
نرى أنفسنا في شخصية خالد بن الوليد، حينما تيقّن أنّه قبل إسلامه كان يجاهد ويقاتل فقط لحب الظهور، لا لمبادئ كبرى ولا لقضية تدفعه، فدخل في الإسلام دون ترددٍ بعد تخلصه من كل شك يقف عائقًا في طريقه، حتى أصبح سيفًا من سيوف الحق التي تناضل لمبدأ وقضية وهدف عظيم..
نرى أنفسنا في شخصية علي بن أبي طالب وحرصه على تعلم الإسلام والتمسك به منذ صغره، وتكفله ببعض المهمات التي قد تهدد حياته..
نرى أنفسنا في شخصية عثمان بن عفان، وأبي عبيدة بن الجراح.. في شخصية الزبير وطلحة، وسعد وعبد الرحمن..
في شخصية زيد بن ثابت وأبي سلمة، في أبي ذر وغيرهم من الصحابة..
نرى أنفسنا في شخصية الصحابيات اللواتي ضحين بوقتهن وجهدهن، بل وبأغلى ما يملكن في سبيل أن يسود نور الإسلام كل مكان وزمان، سواء أكنَّ مربياتٍ تخرجن جيلاً تشرب الإسلام منذ صغره، أو زوجاتٍ تمد أزواجهن بالدعم المعنوي والقوة والأمل في حال ضعفهم وإصابتهم باليأس، أو كن مجاهداتٍ في الحروب تطببن وتداوين الجرحى هنا وهناك، أو كن ممن يشاركن الصحابة في نشر رسالة الإسلام والتكفل بتعليم المسلمين الجدد تعاليم دينهم الحنيف..
نعم نرى أنفسنا فيهم في وقت ضعفنا وشدتنا، فهم بشر مثلنا مثلهم، ولكنَّ الفرق بيننا وبينهم أنّهم جعلوا دين الإسلام مركز حياتهم، كيف لا وقد حررهم من قيود الجاهلية والعبودية وجعلهم أناسًا فاعلين في مجتمعهم، ومكنهم من فهم دورهم وسبب وجودهم في الحياة؟ وكانوا متحدين لا تشكل الأجناس والأعراق عائقا أمامهم، لأنّهم كانوا ينظرون إلى الإنسان فقط، بغض النظر عن لونه وشكله، وكانت الرابطة التي تجعلهم يتعالون عن كلِّ هذه الأمور هي لا إله إلا الله، هذه الجملة التي كانت كافلة بتغيير حياة التهاون والكسل والتيه إلى حياة العمل والجد والجهاد، كان كل فرد منهم جيشًا بأكمله، كيف لا وقد كانت إحدى أهم الآيات في القرآن قد حفرت في عقولهم، ألا وهي {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}، فأصبحوا أهلاَ لأن يكونوا ممن قال الله فيهم {رضي الله عنهم ورضوا عنه}.
ولا شك أنَّنا إن جعلنا القرآن منهاجًا لنا في جميع أمورنا وتمسكنا بتعاليم ديننا كما علمنا المعلم والمربي محمد أفضل الصلاة والسلام عليه.. كما فعل الصحابة الأوائل، فلربما نصبح أيضًا في زمرة من رضي الله عنهم، ونعرف دورنا ومسؤوليتنا في هذه الحياة.
بدل أن نروي قصص الشخصيات الخيالية (كسوبر مان والرجل العنكبوت وغيرهم) لأبنائنا وطلابنا فتصبح مثلهم الأعلى، فلتكن حياة الصحابة الكرام هي ما يتربون وينشؤون عليها، فشتان بين قصة ترويها عن شخصية حقيقية صاحبة مبدأ وقضية يمكن الاقتداء بها، وبين قصة عن شخصية لا وجود لها سوى في عالم الخيال، دورها الوحيد إشغال العقول وإلهاؤها عن قضايا أمتنا الكبرى..
إن كنا حقا نريد أن يولد الإسلام من جديد، فعلينا في البداية أن نولد نحن من جديد، نتحرر من قيود التبعية والعبودية لأوهام وخرافاتٍ، وأن نزيح الكسل والضعف والتهاون الذي أصابنا، مقتدين بمدرسة الإسلام العظمى، مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام..