


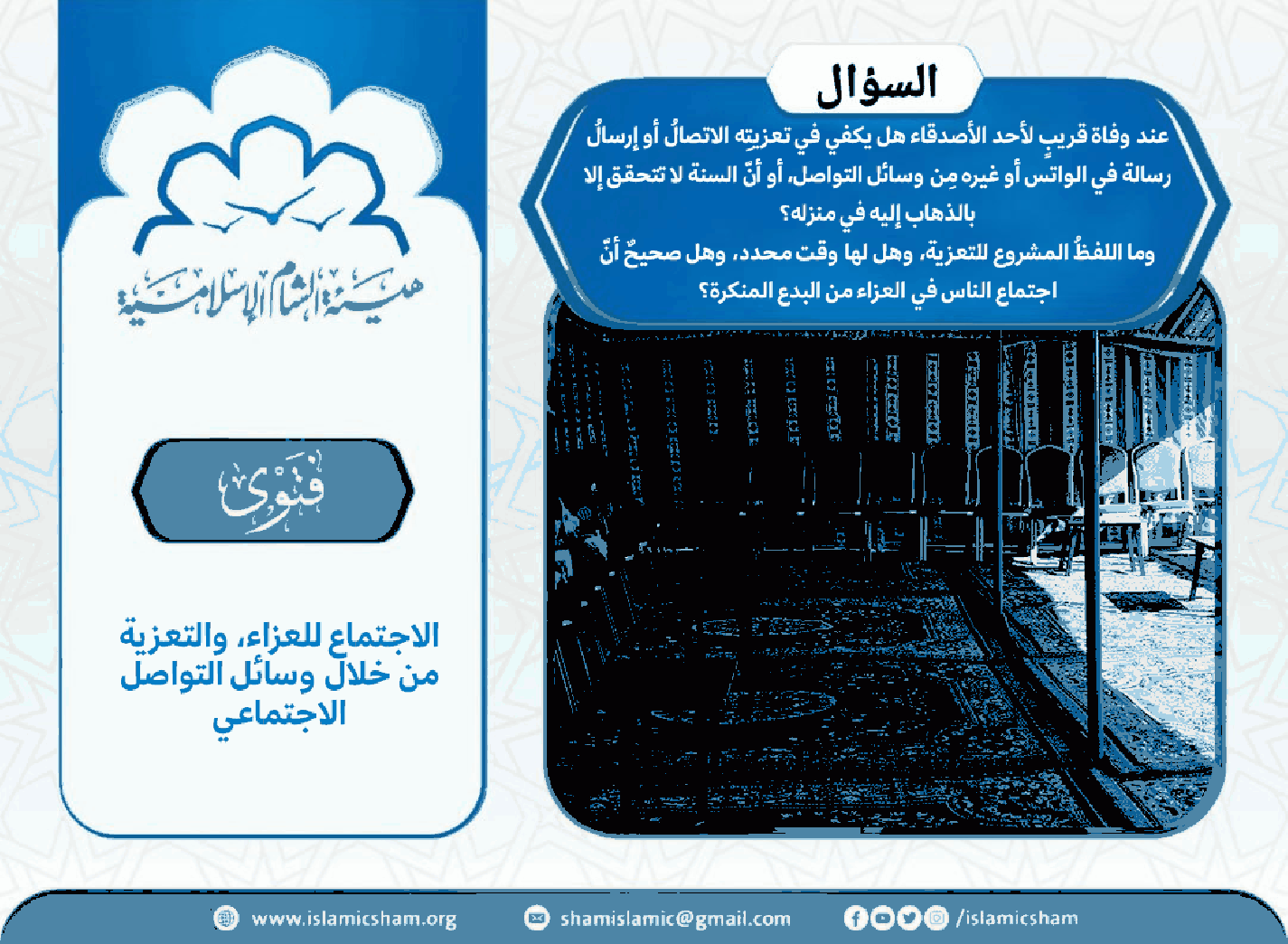





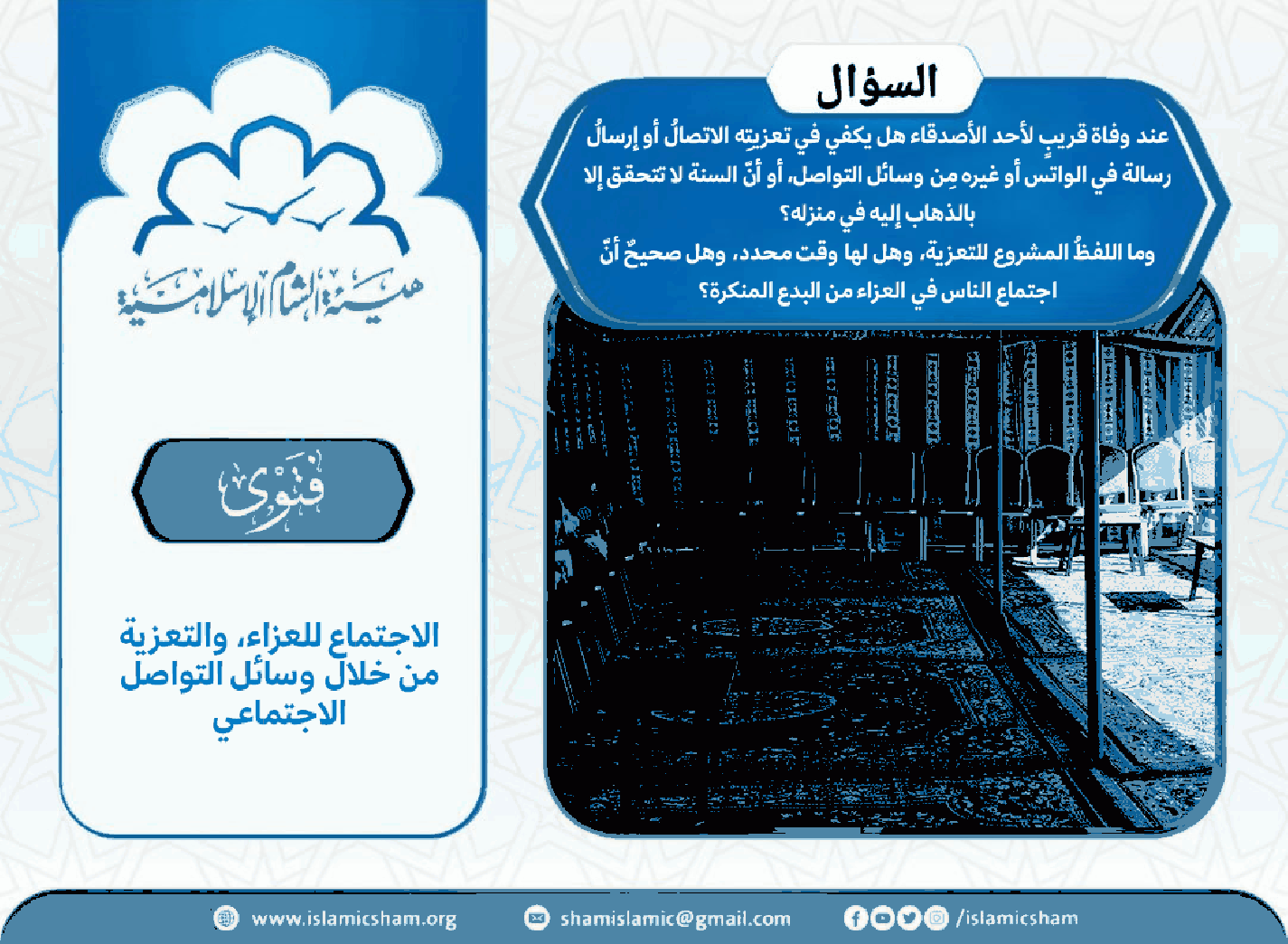



مراحل كثيرة مرت على الأمة ليست هذه أولها، وبطبيعة الحال لن تكون الأخيرة... مِحَنٌ ومِنَح.. بروز وأُفول... سُنة تسري حتى على الأمة الإسلامية ما تلبّست بأسبابها سلبًا أو إيجابًا... سقطت القدس بأيدي الصليبيين (1099م)، سقطت بغداد بأيدي المغول (1258)، سقطت غرناطة في الأندلس (1492)، هُزم العثمانيون في معركة فيينا (1683)، احتُلت فلسطين (1948).
فساد الحكام واستبدادهم، غياب قيمتَيْ العدل والحرية، تفرق المسلمين واقتتالهم وتحالفاتهم مع الأعداء ضد بعضهم، تبَعية الشعوب وتخاذلها، خيانة الكثير من العلماء للأمانة، دخول الدنيا على المسلمين وانغماس حكامهم في ملذاتها، تشوّه مفهوم الإيمان واختلال التوازن بين بُعدي المادة والروح في حياة المسلمين... عوامل مشتركة كانت وما تزال السبب في السقوط المدوّي للأمة عبر التاريخ.
لتصبح المعادلة أكثر وضوحًا:
• عودة إلى الدين مصحوبة بالبناء الفكري والعقائدي والسلوكي والحضاري يتبعها نصرٌ فتمكين...
• رِدّة عن الدين (وليس المقصود هنا بالضرورة خروج من الملّة) في الفكر والسلوك يتبعها انحدارٌ فانكسار فهزائم متوالية...
وهكذا كان، فبسببٍ من افتتان الحكّام بالدنيا.. بدأت الحروب الصليبية... وفي إطار عودة القادة إلى المنهج الرباني المتوازن اختُتمت هذه الحروب بانتصار المسلمين على الصليبيين.
وبين البدء والانتهاء كَـرٌّ وفَرّ، انتصارات وهزائم، دروس وعبر...
وإثر كل هزيمة يقف العقلاء لينظروا في أسبابها وليُلَمْلموا جراحاتهم ليعيدوا البناء من جديد على ضوء تلك النتائج.. وهذا ما فعله عدد من قادة المسلمين عبر التاريخ منذ انتصار القائد ألب أرسلان في معركة ملاذ كرد على الصليبيين (463هـ)، مرورًا بانتصار القاضي أبي بكر ابن الخشاب الذي قاد المقاومة الشعبية عندما حوصرت حلب (518هـ) بالتعاون مع أمير الموصل أقسنقر البرسقي، الذي اعتبره المؤرخون نقطة البداية الحقيقية لتحرير فلسطين لأنها شكلت نواة الوحدة بين العراق وبلاد الشام، وهكذا... استمر جهاد المسلمين ضد الصليبيين الذين تمكنوا من تأسيس أربع إمارات لاتينية في قلب العالم الإسلامي هي: الرُّها، أنطاكية، بيت المقدس، وطرابلس...
إلى أن استلم عماد الدين زنكي القيادة (522هـ) وكان ذا دهاء وقوة وتديُّن، وكانت له رؤيته الاستراتيجية في توحيد المسلمين في بلاد الشام ومصر ضمن خطته لتحرير فلسطين؛ حيث وحّد الجهود ووظف الطاقات لتحقيق هذا الهدف، فاستطاع أن يُسقط إمارة الرُّها (539هـ)، التي شكّلت ضربة قوية لوجودهم. وبعد عماد الدين استلم الراية ابنه نور الدين عمود (541هـ) الذي اعتبره بعض المؤرخين على أنه الخليفة السادس بسبب قدرته على الجمع بين تحكيم مبادئ الشريعة ومعطيات واقعه المعاصر مع ذكاء وتقوى وتجرد عن المصالح الشخصية وحرص على بناء الحياة وفق الرؤية الإسلامية..
وفي كنف نور الدين نشأ صلاح الدين الأيوبي الذي استلم الراية من بعده (569هـ)، مكملًا مسيرة البناء الفكري والعقائدي والروحي والعسكري والسياسي والاجتماعي... مستثمرًا كل الإنجازات المتراكمة منذ عام 463هـ إلى أن حرر بيت المقدس في رجب 583هـ.
إذًا، لم يكن الانتصار المدوّي الذي حققه الله على يد صلاح الدين وجُنْدِه بمعزِلٍ عن تلك العوامل التي صنعته... ومن الإجحاف قصر تحقيق الانتصار على صلاح الدين وحده؛ وإنما اعتاد الناس على فكرة القائد الملهَم - فريد عصره وزمانه - الذي تُختصر كل الإنجازات والانتصارات بشخصه الكريم! بحيث ينسَوْن أن النتائج إنما تُبنى على مقدِّمات ممهِّدة لها، وهي مجموعة عوامل تتداخل لتشكّل المشهد بأكمله...
ولعل هذا المفهوم قد عطّل طاقات وجهود الكثيرين على مستوى الأفراد والجماعات؛ فكلٌّ لا يرى لنفسه دورًا يُذكر ما دام القائد لم يأتِ بعد، والجميع ينتظر قدومه الميمون، وقد نسي أنّ تضافر الجهود وتراكم الخبرات في مختلف مجالات الحياة يسبقها فهمٌ عميق للسنن الربانية في قوانين النصر والهزيمة.. إنما هو إعدادٌ يصنع ذلك الصعود المنتظَر.. بعدها؛ فإن وجود القائد تحصيل حاصل لبيئة أفرزته وهيأته ليستكمل جهودها ويرفع لواءها ويقودها نحو أهدافها.
وبعد، فقد آن لعقولنا أن توسّع نطاق الرؤية لتشمل جميع جزئيات وأبعاد الصورة، وتتحرر من نطاق الشخصنة وتضخيم الأفراد واختزال الأمة بهم.. وهذا بالطبع لا يطعن بالقادة أنفسهم ولا يغمطهم حقَّهم ولا ينازعهم مكانتهم اللائقة بهم، وإنما يعيد تعريف المفاهيم التي درجنا عليها ثم اكتشفنا أن الكثير منها يحتاج إلى إعادة نظر.