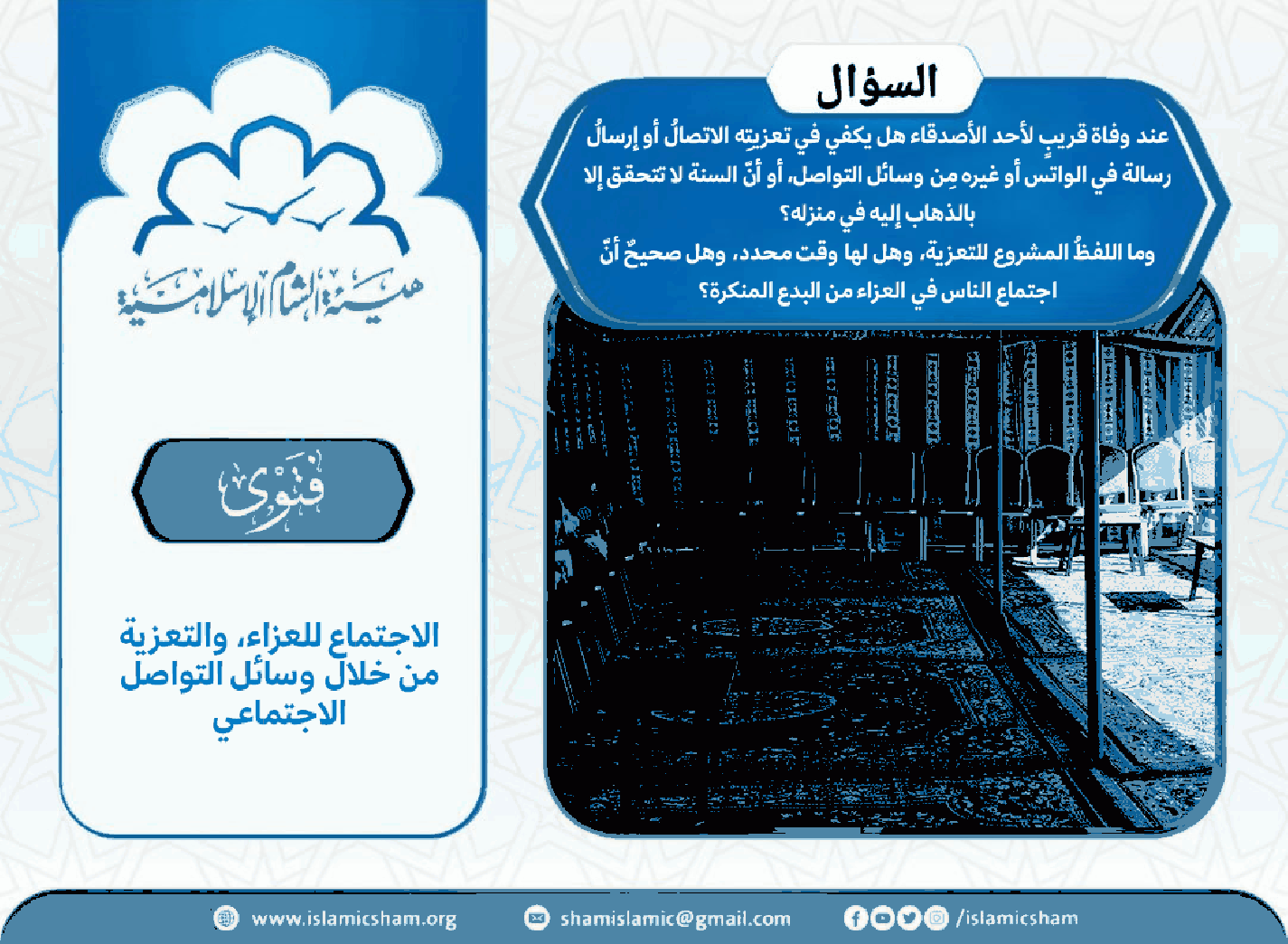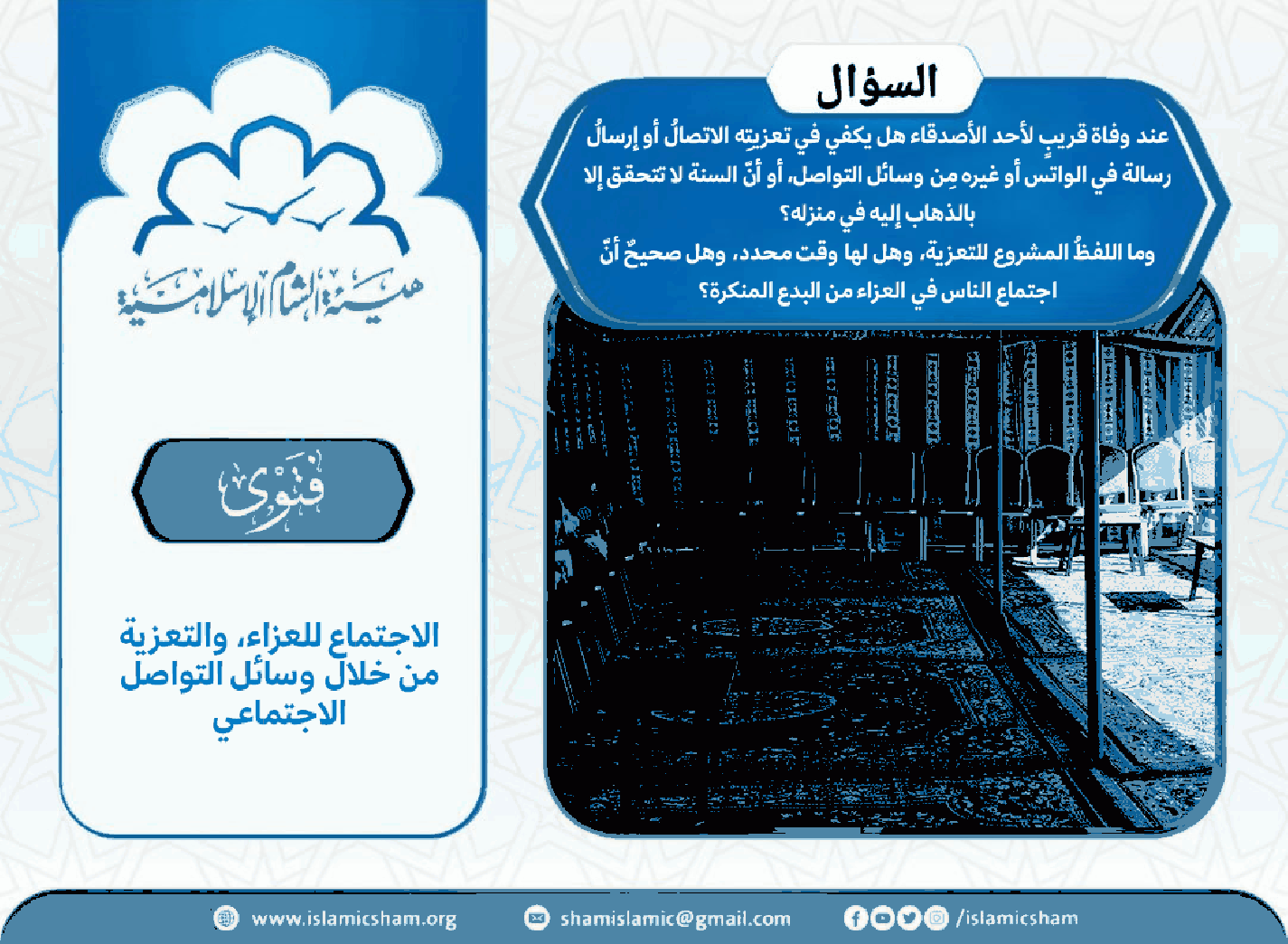طبيعة الحياة أنَّ الإنسان مضطر للاجتماع والتعارف والتعامل والتعاون مع غيره، ولا يمكنه أن يعيش في عزلة أو انفراد عن الآخرين، صلحاء أو غير ذلك، ولا تقوم الحياة إلا بذلك، قال تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا}.
كما أنه ليس كل ما يعرض للإنسان يستطيع أن يكاشف به الآخرين في كل وقت وعلى أي حال، وإلا لاختل الاجتماع ووقع النزاع، فشرعَ الله للإنسان أن يحمي نفسه من الوقوع في الشر، أو تقليله، دون أن يتنازل عن مبادئه أو يرتكب المحرمات، وهو ما يُعرف شرعًا بالمداراة.
والمداراة تعني: ملاينة الناس، واحتمالهم، وتُجنب ما يُشعرهم بالبغض أو الغضب.
ولا تعني المداراة التنازل عن المبادئ والقيم. وهذه المداراة شاملة لجميع أمور الحياة.
والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط:
فالطرف الأول: يصادم الناس، ويصدع بكل ما يعتقده ويراه، دون أي مراعاة أو حساب، تحت زعم قول الحق والجهر به، وعدم الخشية إلا من الله، وعدم الرضى بالظلم والدونية، وغير ذلك!
وهذا النوع من الناس لا يتبع الحكمة في التعامل مع الأعداء، بل سائر الناس، فسرعان ما يفتح على نفسه أبواب النزاعات، ويُكثر من حوله الأعداء، وكثيرًا ما يتسبب لنفسه بالضرر في دينه ودنياه.
وإذا كان هذا الشخص من القادة أو المسؤولين فإنه يعلن أنه لا يقبل أمراً إلا أن يحصل على جميع ما يريده، ولا يقبل بنقصان أو تأجيل شيء منه، وحينذاك فإن الضرر لا يقتصر على شخصه، بل إنه يجلبه على المجتمع كله، فيدخله في صراعات هو غني عنها، بينما كان يمكنه تأخير كثيرٍ من العداوات، أو تحييد بعض الخصوم، فيجلب لمجتمعه الخير، أو يجنبه شرًا كثيرًا.
والطرف الثاني: على النقيض من الأول، فهو يداهن الأعداء، وينافق الظالمين، ويسكت عن الظلم والمعاصي، بل يسكت حتى في حالات الكفر والنفاق الواضحة الظاهرة، ويقبل بالباطل حرصًا على دنيا أو مصلحة متوهمة. وهذا فعله محرّم، وكبيرة من كبائر الذنوب.
أما الطرف الوسط المعتدل، فهو يتبع السياسة الشرعية كما جاءت في الأدلة الشرعية، فهو يداري رغبة في تحقيق مصالح دينية ودنيوية أكيدة، من غير أن يداهن في دين الله تعالى، أو يتنازل عن مبادئه وثوابته.
وقد قال تعالى عن موسى عليه السلام في حديثه لأكفر أهل الأرض في زمانه، وهو فرعون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}.
بل هذا هو منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين معلومي الكفر والنفاق، بل مع من في طبعهم سوء وغلظة، فعن عُرْوَة بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَما أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ) فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الكَلاَمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلاَمَ؟ قَالَ: ( أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ) متفق عليه.
وإن هذه المداراة تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة، فمن تطبيقاتها السياسية: تحييد الخصوم، وعقد التحالفات، والعمل على المصالح المشتركة وتقاطعها، والتدرج في تحقيق الأهداف، وعدم إشاعتها أو إعلانها على الملأ، والواقعية في الشعارات والمشاريع.
ولولا مداراة الرسول صلى الله عليه وسلم للأعداء من اليهود والمنافقين، وصبره على الأعراب الغلاظ الجفاة لما تمكن من نشر دعوته، وتأمين أصحابه، سيما في بداية أمره، ولهذا كان ينهاهم عن مواجهة الأعداء، ويأمرهم بالصبر والاحتساب، ويذكرهم بما لاقاه أتباع الرسل من قبل، ويحذرهم من الاستعجال، وينهاهم عن التهور والارتجال.
بل إن الإنسان ليحتاج إلى هذه المداراة في حياته الخاصة، تجاه قريب، أو زميل، أو جارٍ يكرهه أو بينهما عدم انسجام أو عداء، ولا يُعد ذلك نفاقًا أو مداهنة، بل هو من الذكاء والحكمة في التعامل.
فالمداراة والتعامل بأصول السياسة الشرعية، ومخالطة الناس والصبر على أذاهم، هو المشروع في الدين، بشرط ألا يكون في ذلك تنازل عن المبادئ أو تأييد الظلم، أو السكوت عن الفساد، أو أن يكون ذلك على حساب التنازلات والمساومات. وأن يبذل الممكن والمستطاع لإقامة دين الله في الأرض، والتمكين للمسلمين، والتوفيقُ والنجاحُ بعد ذلك بيد الله تعالى.