


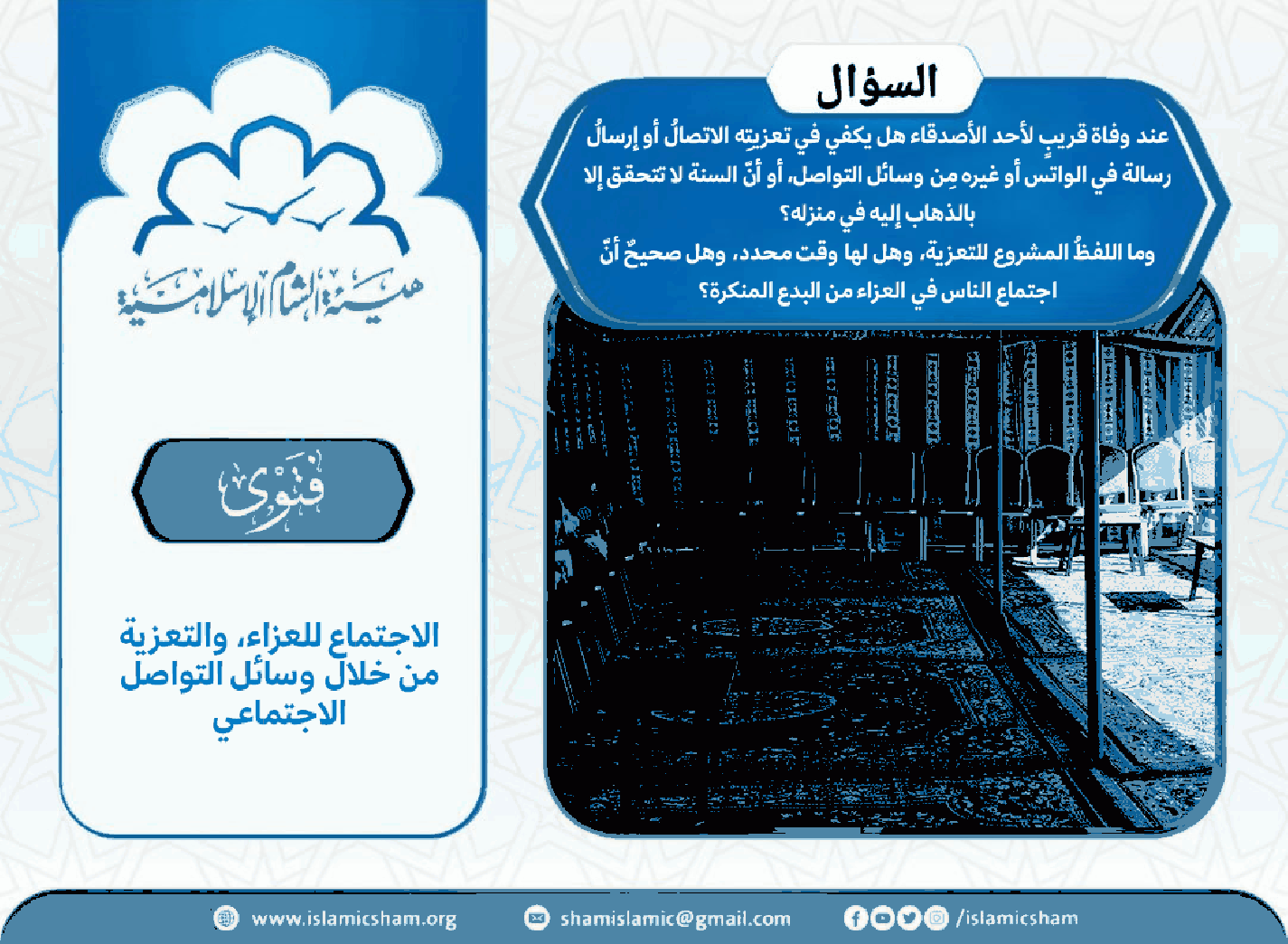





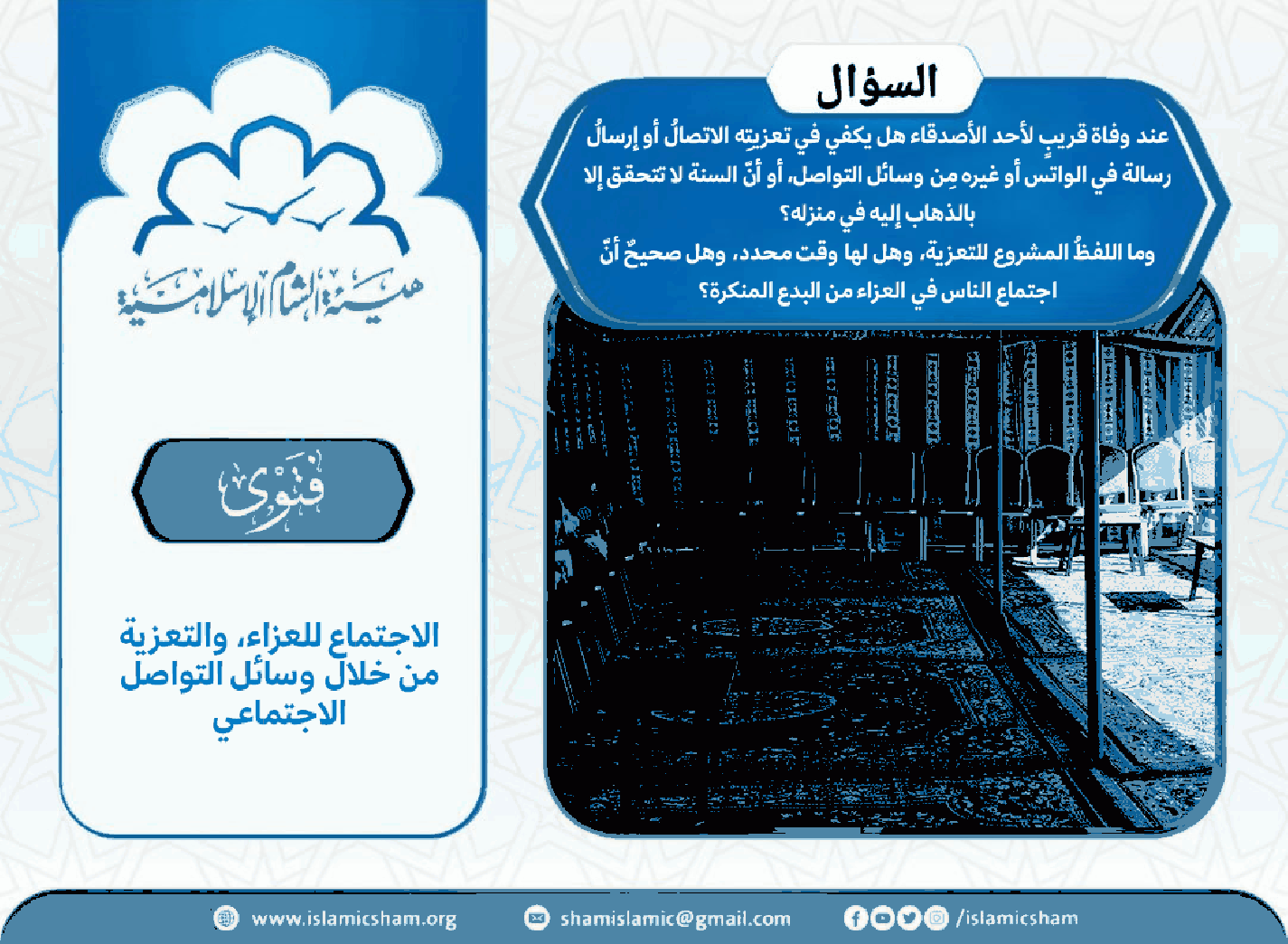



كان صوته نديًّا وهو يشق عُباب الفجر، ويفتتح الصباح بأنفاس القرآن. كان لتقاسيم صوته -وهو يمدها في أَلْق الآيات- نسيمٌ يخالط الرُّوح، وسحابٌ نديٌّ يغسل النفس، ويعيد إليها قيمة الحياة.
كانت آخر آية توقف عندها هي قول الحق: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء: 106].
انتهى الصوت في لجة الصمت، وتَناهَى بعيدًا بعيدًا، كبقايا دُخَانٍ أخذ يغيب عن الأنظار، وبعد في أفق السماء. أما أنا فقد بدأت معي رحلة المعنى!
استوقفتني الكلمات الثلاث الأولى: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ}، وصرت أرددها بهمس، وأذوب في أعماقها وجرسها العجيب، في هذه "القافات" الثلاث التي تتكرر في كل كلمة، لتصنع دهشةً تتسلل عبر الأذن وتقع في أعماق الروح.
إنك تجد بيانك قاصرًا عن بيان سرها، وما تحس به من هزة عنيفة في داخلك، فلا تملك إلا أن تستمع لصوتها في داخلك يتهادى كموجٍ هادرٍ في بحر لجي!
عادت بي الذكريات إلى لحظة قديمة قلت فيها لبعض الأصدقاء: لماذا لا يكون لدينا مجالس لسماع القرآن فحسب؟ لماذا لا نتحلق في المساجد بُعَيدَ الصلاة نستمع إلى قارئ عذب الصوت يرتل على أسماعنا آيات القرآن؟
لقد عشنا عقودًا من حياتنا نتحلق حول الخطباء والوعاظ والعلماء نسمع منهم كلام الخلق، ولم نجلس متحلِّقين كسكون الصحراء نستمع لوقع المطر القرآني على رمالها.
الآية السابقة من سورة الإسراء فيها لفتة عجيبة إلى هذا المعنى الغائب عنا، فقد وصفت الآية القرآن بوصفين، وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أمرين متعلقين بالوصفين.
أما الوصف الأول: فكون القرآن مقروءًا، وهذا مأخوذ من اسمه (وقرآنًا).
وأما الوصف الثاني: فكون القرآن مفروقًا مُنَجَّمًا لم ينزل دفعة واحد (فرقناه).
وما دام القرآن مقروءًا فاقرأه (على الناس)، وما دام منجمًا مفروقًا فاقرأه (على مكث).
إن الآية تخبرنا بصراحة متناهية أن القرآن نزل (لتقرأه على الناس)، فهل نقرأ القرآن على الناس ونسمعهم كلام ربهم؟
والآية تخبرنا أن هذه القراءة على الناس تكون (على مكث)، والمكث: الهدوء والتُّؤَدة.
وفي هذا اللفظ الثلاثي (مكث) من اللطف والرقة ما يجعله يسرى كنسيم بارد فيعانق شغاف القلوب، ثم إذا أمعنت النظر مرة أخرى وسألت نفسك: لِمَ آثَرَ التعبير القرآني هذا اللفظ "المكث" دون غيره كـ"الهدوء" و"البطء"؟ فإنك ستجد في هذه اللفظة معنًى دقيقًا وسرًّا عجيبًا؛ ذلك أن "المكث" يحمل معنى الانتظار وعدم الاستعجال، و"مَكَثَ فلانٌ" أي: انتظَرَ، وهو معنى منصوص عليه في كتب اللغة؛ ففي معجم المقاييس: "الميم والكاف والثاء كلمةٌ تدلُّ على توقف وانتظار".
هذا الانتظار هو الذي يدعو النبيَّ صلى الله عليه وسلم -صاحبَ هذه المعجزة- وأتباعَه -حملةَ القرآن- على أن يقرؤوا على الناس القرآن، وينتظروا، ويصبروا، ويداوموا؛ لأن الانتظار والمكث على هذه القراءة سيجعلها تؤتي ثمارها في لحظة مواتية تتمكن فيها الآيات من النفوس.
فإذا قَرَنتَ هذا المعنى بقول الله تعالى: {إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37].
رأيت أن الذكرى تحصل بتدبر القلب، وتحصل كذلك بإلقاء السمع. ولاحِظ هذا التعبير القرآني الذي آثر هذه الاستعارة (ألقى السمع) على الاستخدام المباشر "استمع" حيث إن مجرد "إلقاء السمع" العابر مع حضور القلب يحدث الذكرى التي هي غاية حياة القلوب.
إن الاستماع للقرآن هداية عظيمة غفلنا عنها كثيرًا كثيرًا. وهي تختلف عن تعلم القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن، وفي كلٍّ خير، لكن قضية "الاستماع" هذه حاضرة في النص القرآني بطريقة ملفتة للنظر.
ولعلك -إذا تأملت القرآن- تدرك سرًّا من أسرار تقديم السمع على البصر في أغلب آيات الكتاب العزيز؛ فالسمع هو منفذ المعرفة الأكثر سطوةً في توجيه العقل الإنساني.
إن الله تعالى أوحى إلى نبيه هذا الكتاب المعجز، وكان من إعجازه أنه يحمل دليله عليه فيه وليس معه، فإذا رفرفت كلماتُه في فضاء الكون والتقطتها أذن واعية استدلت هذه الأذن من فحوى الكلام أن شيئًا غير مسبوق يسري في أجساد الكلمات فيحيلها أرواحًا تتعانق في جو السماء.
ولذلك أمر الله تعالى نبيه بأمر يقيم به الحجة على مشركي العرب، غاية هذا الأمر أن يسمعهم هذا الكلام المعجز؛ فقال له: {وإنْ أحدٌ مِنَ المشرِكينَ استجارَكَ فأَجِرْهُ حتى يسمعَ كلامَ اللهِ ثم أبلِغْهُ مَأمَنَهُ} [التوبة: 6].
إنها فرصة مواتية لعرض الدعوة وإقامة الحجة وقوامها "سماع كلام الله"، وتأمل كيف آثر هذا التعبير (كلام الله) عن غيره من الألفاظ كـ"القرآن" و"الكتاب" و"الذكر" وغيرها، ولا تغفل عنه؛ ذلك لأن المستمع حين يستمع سيدرك أن المسموع هو "كلام الله"، ومن سمع "كلام الله" حُقَّ له أن يبلغ مأمنه.
ونحن ما زلنا نعيش في عالم الخوف ولم نبلغ المأمن؛ لأننا حتى هذه اللحظة ما زلنا مفرِّطين في قضية الاستماع للقرآن.
إن الآمال معقودة في أن نعيد النظر في قضية "الاستماع إلى القرآن"؛ فقد كثرت سماعاتنا لغيره، وعلقت الآمال بكلام غيره من البشر الذين نستمع إلى حديثهم، فتبهرنا بلاغتهم، وتأسرنا فصاحتهم، ولكنها دهشة اللحظة التي تنقضي بانقضاء صاحبها، وتنتهي بانتهاء حروفها. أما استماع "كلام الله" فإنه يخلق في النفس دهشة لا تنقضي، وإعجابا لا ينتهي، وبركة تُظِلُّ صاحبَها بالهداية والصلاح. وكم سجل لنا تاريخ الدعوة قصصًا كان استماع القرآن فيها بداية لحياة أصحابها.
فهل سيتحقق الأمل، ونرى مجالس في بيوت الله يتحلق فيها الناس ليسمعوا كلام الله، بأصوات رخيمة لا تكلف فيها، ولا تدخُّل فيها لكلام البشر؛ لنحقق معنى النهج والهدي القرآني الذي يقول: {وقرآنًا فرَقْناهُ لتقرأَهُ على الناسِ على مُكْثٍ ونزَّلْناهُ تنزيلاً}.