


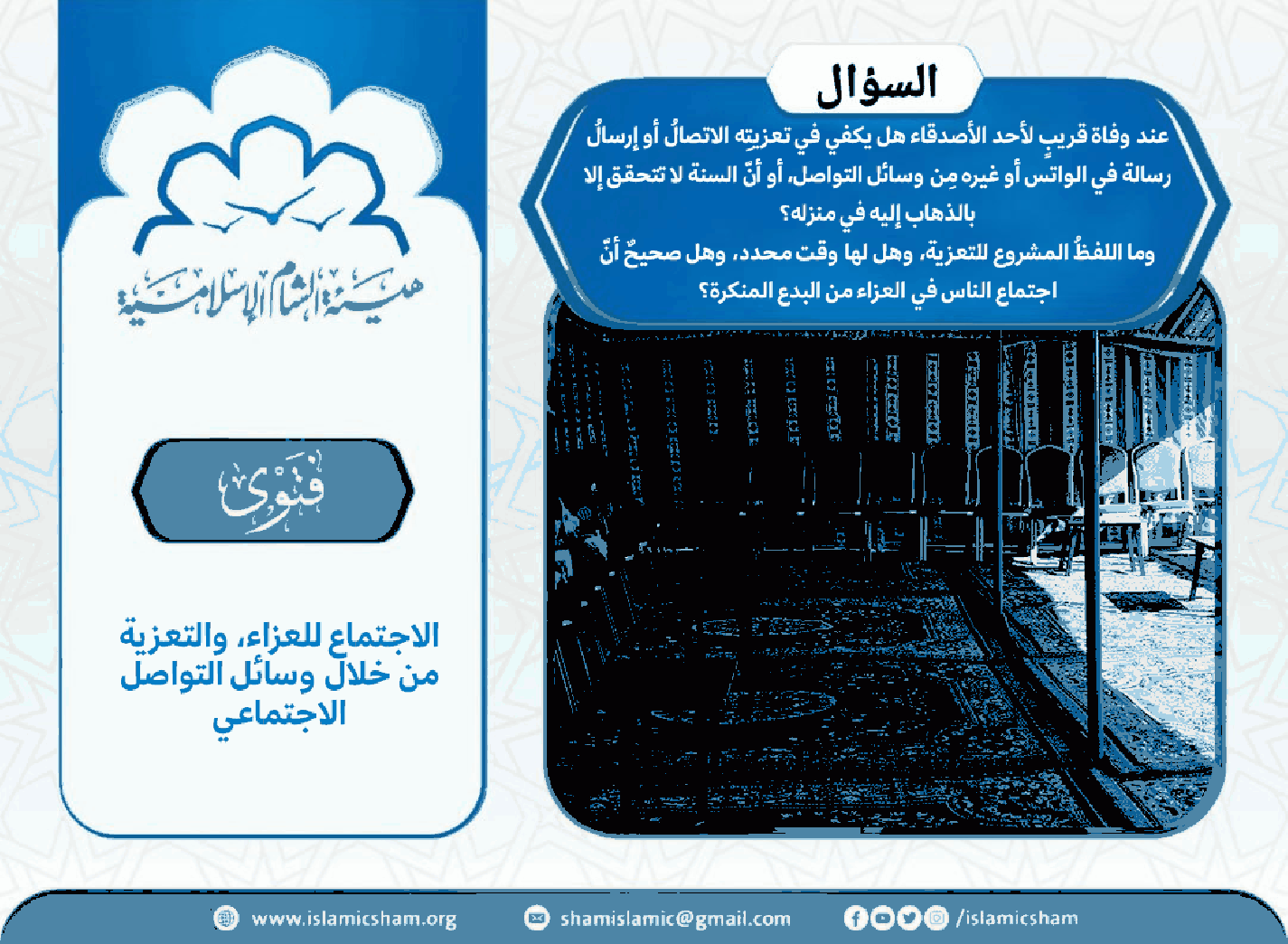





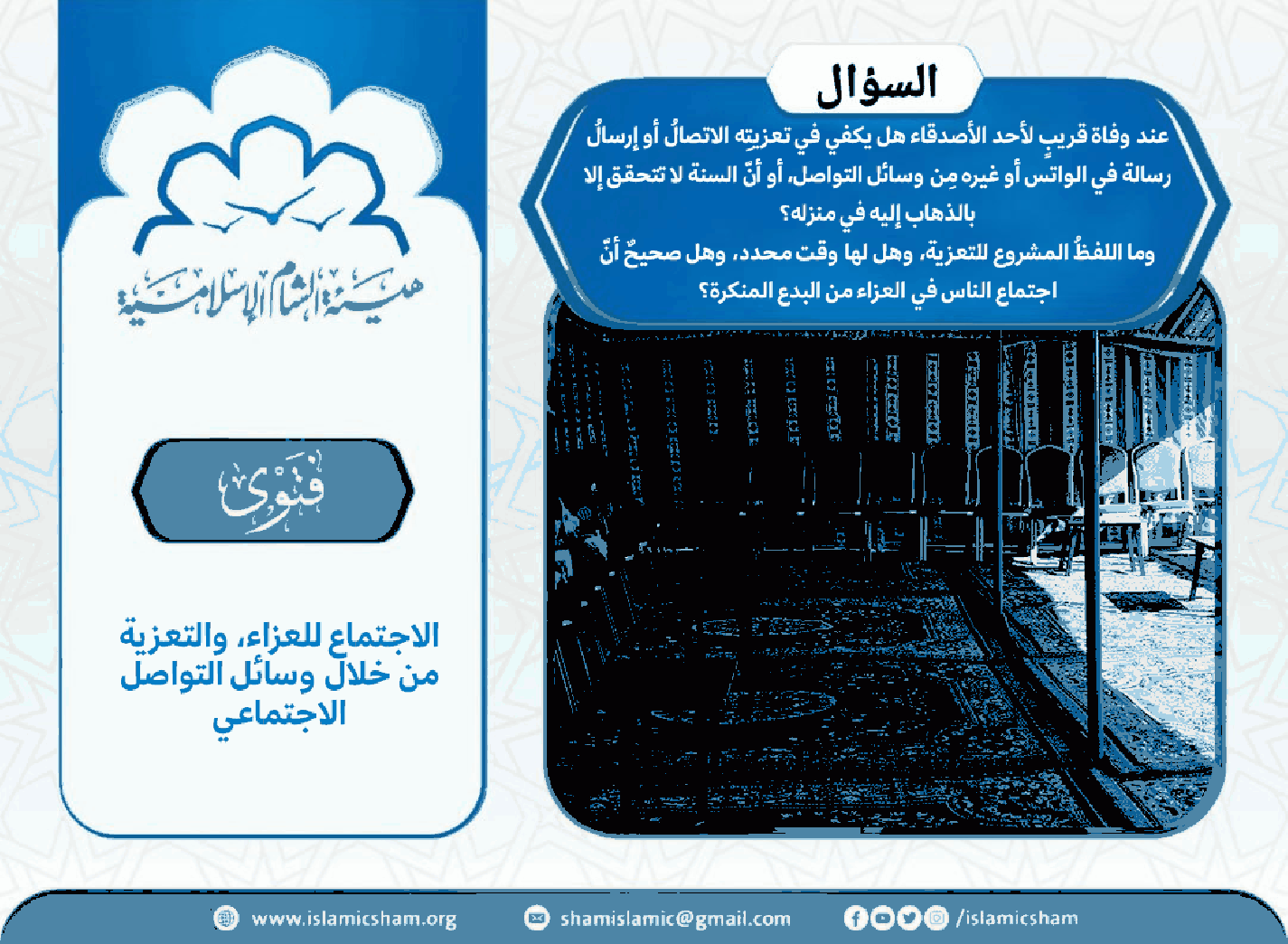



ما أكثر المحن والابتلاءات والشدائد، وما أحوجنا إلى الثبات والصبر فيها، ولن نجد ثباتاً مثل الذي يورثه الفهم الصحيح لحقائق الإسلام الكبرى.
وفي هذا المقال المختصر أحاول أن أجليَ قاعدة عظيمة للتثبيت وقت الشدة، سائلاً الله عز وجل أن يجد فيها المبتلى سلواناً لمصابه، والمضطر جلاءً لأحزانه، والمعافى تثبيتاً لجنانه.
وسأقدم للقاعدة بثلاث مقدمات، هي حقائق راسخة عند كل مسلم مهما كان مقدار علمه، أو مستوى تدينه، وهذه الحقائق هي:
الحقيقة الأولى:
الدنيا متاع قليل حقير، لا تساوي عند الله شيئاً، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء.
ومن حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة أن نعيمها مهما كثر يتلاشى أمام أدنى عذاب في الآخرة، وبؤسها مهما اشتد يُنسى أمام أدنى نعيم في الجنة.
" يؤتى بأنعمِ أَهلِ الدُّنيا من أَهلِ النَّارِ يومَ القيامةِ فيُصبغُ في النَّارِ صبغةً ثمَّ يقالُ يا ابنَ آدمَ هل رأيتَ خيرًا قطُّ هل مرَّ بِك نعيمٌ قطُّ فيقولُ لا واللَّهِ يا ربِّ ويؤتَى بأشدِّ النَّاسِ بؤسًا في الدُّنيا من أَهلِ الجنَّةِ فيُصبَغُ صبغةً في الجنَّةِ فيقالُ لهُ يا ابنَ آدمَ هل رأيتَ بؤسًا قطُّ هل مرَّ بِك شدَّةٌ قطُّ فيقولُ لا واللَّهِ يا ربِّ ما مرَّ بي بؤسٌ قطُّ ولا رأيتُ شدَّةً قطُّ"
الحقيقة الثانية:
أن المؤمن كريم على الله، فالله ولي المؤمنين ومولاهم، هو معهم، يحبهم ويتولاهم، ويصلي عليهم، وهو رحيم بهم.
الحقيقة الثالثة:
أن الكافر مهين عند الله، فالله لا يحب الكافرين، وهو عدو لهم، نسوا الله فنسيهم، ولعنهم وغضب عليهم.
والمؤمن والكافر كلاهما يعمل الحسنات ويعمل السيئات، وأعظم حسنة للمؤمن إيمانه، وأكبر سيئة للكافر كفره. أما حسنات الكافر فهي ما يفعله في هذه الدنيا من أعمال الخير والنفع العام. واقتضى عدل الله وحكمته أنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، فهو يثيب العامل على حسناته، ويعاقب المسيء على سيئاته إلا أن يعفو.
وهنا نأتي إلى القاعدة العظيمة في الثبات:
لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئاً، ولأن المؤمن كريم على الله:
فإن الله لم يرض الدنيا ثواباً لحسنات المؤمن، ولكنه رضيها تكفيراً لسيئاته
ولأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئاً، ولأن الكافر مهين على الله:
فإن الله لم يرض الدنيا عقاباً لسيئات الكافر، ولكنه رضيها ثواباً لحسناته
ولنقف قليلاً عند أجزاء هذه القاعدة:
" لم يرض الله الدنيا ثواباً لحسنات المؤمن"، فالدنيا لا تستحق أن تكون الثواب الأوفى لحسنات المؤمن الكريم على الله.
وقد يقال: ولكن ألسنا نرى بعض المؤمنين في حال حسنة في هذه الدنيا؟
فالجواب: قد يعطي الله المؤمن من الدنيا من العافية وسعة الرزق والرغد والأمن، ولكن هذا العطاء ليس الجزاء الأوفى لعمله، وإنما قد يكون
وتأمل قوله تعالى:
وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَـنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾
يقول السعدي رحمه الله:
"يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده، التي لا يقدم عليها شيئا، لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما، ولجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي: درجا من فضة عليها يظهرون على سطوحهم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة، ولجعل لهم " زخرفا" أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف، وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفاً عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا
"ولكنه رضي الدنيا تكفيراً لسيئات المؤمن"
فإن الله توعد أصحاب الخطايا بالعقاب، ولما كان المؤمن كريماً على الله، ولكنه خطاء كما هم بنو البشر، جعل الدنيا -التي لا تساوي عنده شيئاً - محلاً لتكفير سيئاته وخطاياه، حتى إذا جاء يوم القيامة كان قد تخفف من ذنوبه أو محيت عنه.
وقد جاء في تأكيد هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"ما يُصيبُ المُسلِمَ، مِن نَصَبٍ ولا وَصَبٍ، ولا هَمٍّ ولا حُزْنٍ ولا أذًى ولا غَمٍّ، حتى الشَّوْكَةِ يُشاكُها، إلا كَفَّرَ اللهُ بِها مِن خَطاياهُ"، وقوله " ما يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمُؤْمِنَةِ في نفسِهِ وولدِهِ ومالِهِ ، حتَّى يلقَى اللهَ وما علَيهِ خطيئةٌ
" ولم يرض الدنيا عقاباً لسيئات الكافر"
فإن بؤس الدنيا مهما اشتد دون ما يستحقه الكافر من العقاب. ولذلك كانت القاعدة المطردة في كتاب الله توعد الكافرين بالعقاب في الآخرة.
لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾
وَلا تَحسَبَنَّ اللَّـهَ غافِلًا عَمّا يَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُم لِيَومٍ تَشخَصُ فيهِ الأَبصارُ ﴿٤٢﴾
"ولكنه رضيها ثواباً لحسناته"
تأمل قول الله تعالى
مَن كانَ يُريدُ الحَياةَ الدُّنيا وَزينَتَها نُوَفِّ إِلَيهِم أَعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا يُبخَسونَ﴿١٥﴾ أُولـئِكَ الَّذينَ لَيسَ لَهُم فِي الآخِرَةِ إِلَّا النّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعوا فيها وَباطِلٌ ما كانوا يَعمَلونَ ﴿١٦﴾
تأمل قوله "نوف" فهو ليس يعطيهم فقط، وإنما يعطيهم عطاء مستوفياً مستغرقاً لكل ما عملوه، وأكده بقوله " وهم فيها لا يبخسون"، حتى لا يبقى لهم في الآخرة منه شيئ، ولا يبقى لهم إلا النار " أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار".
ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابقاً لهذا المعنى:
" وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً"
فما نراه من رغد عيش الكافرين ورفاهيتهم وتمتعهم هو الجزاء الأوفى لاجتهادهم وعملهم في الدنيا.
ونستفيد مما سبق أن قاعدة الثواب والعقاب للمؤمن ليست هي قاعدة الثواب والعقاب للكافر.
فمن الخطأ أن نقارن بين أحوال المؤمن المادية في الدنيا، وأحوال الكافر المادية في الدنيا، إذ كيف نقارن من بلاؤه معجل وثوابه مؤجل، بمن ثوابه معجل وعقابه مؤجل؟!
بل إن ما نراه من غلبة أحوال الابتلاء على المؤمنين وغلبة أحوال رغد العيش على الكافرين هو عين ما تنطق به حقائق هذا الدين. فلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسَع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالساً ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا"، وفي رواية: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟".
فهل أدركنا لماذا قال الله للكافرين "كلوا وتمتعوا قليلاً " بينما قال للمؤمنين:
" اصبروا وصابروا ورابطوا "؟