


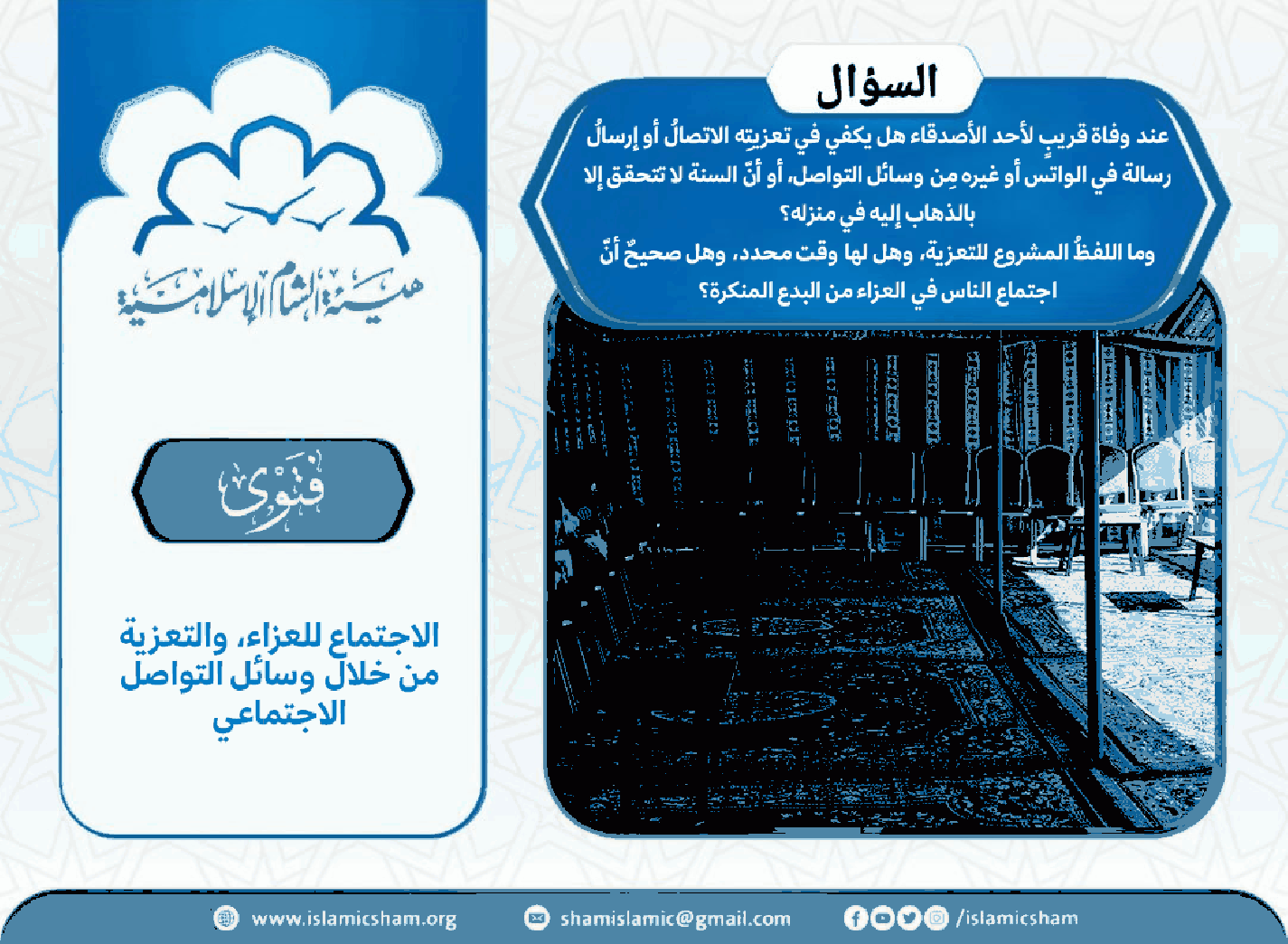





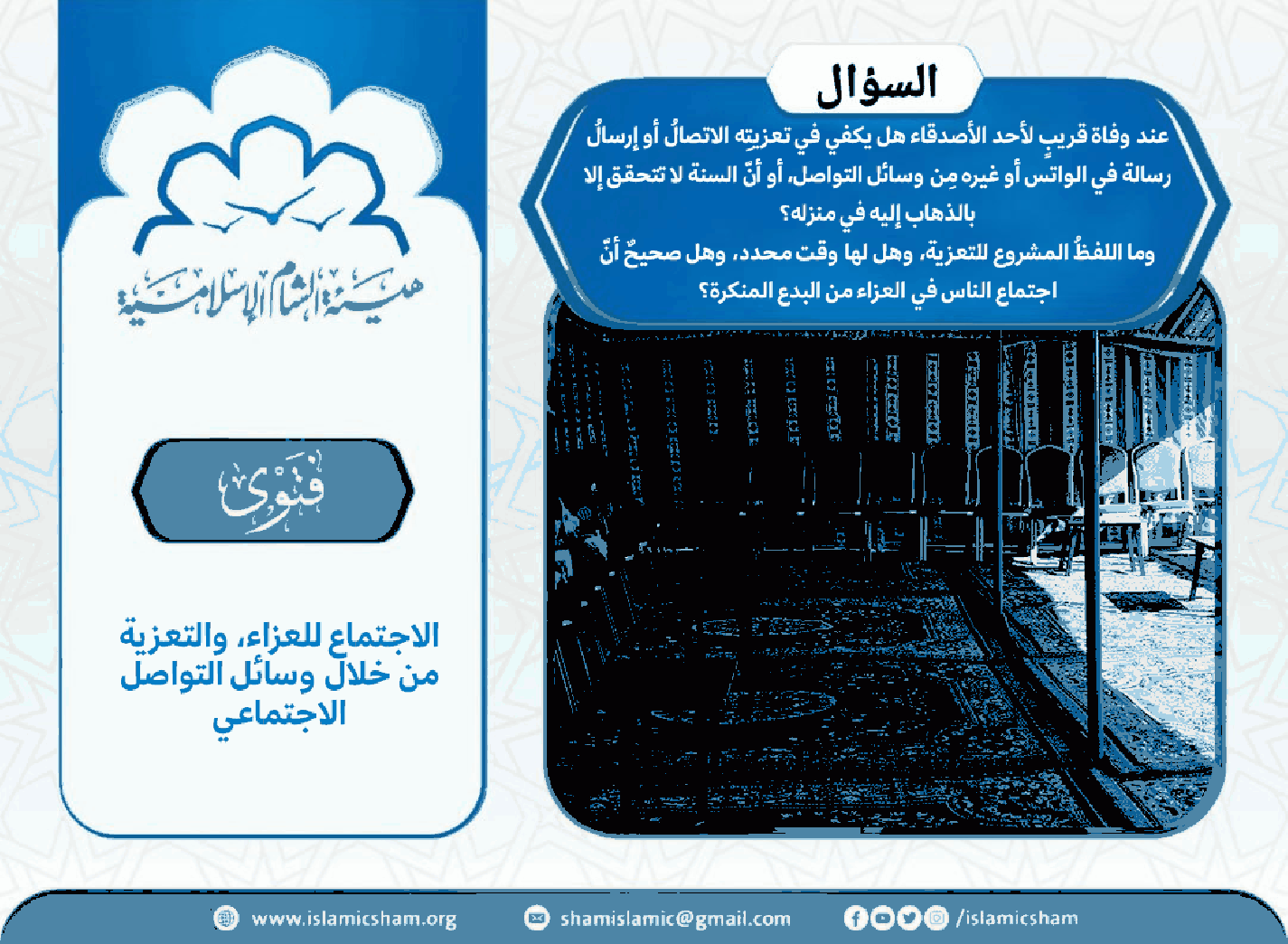



الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلمُ على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:
فهذه قواعد وفوائد من كتاب:"السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية- رحمه الله تعالى- تتعلق بالنظام المالي في الدولة الإسلامية، مما يتعلق بالراعي والرعية، وإليك هذه القواعد والفوائد:
الأولى: الأموال نوعان: أمانات وحقوق
الأموال نوعان: أمانات وحقوق، والأمانة تُؤدَّى بكلِّ حال، ولا يجوز حبسها عن صاحبها، حتى ولو خان هو الأمانة.
والأمانات من الأموال هي الأموال التي قبضت بحق، كالوديعة والعارية والديون ومال الشريك والوكيل ومال اليتيم وغير ذلك، فإذا كانت هذه الأموال واجبٌ أداؤها، فمن باب أولى ما أخذ بغير حق كالغصب والسرقة وغير ذلك.
وأما الحقوق فهي حق المال في الزكاة والنفقات الواجبة على من لزمت نفقته عليه، فكلُّ ذلك يجب أداؤه على وجهه بنفس سمحة وتقرب إلى الله عز وجل.
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية" (ص: 24-27):" القسم الثاني من الأمانات: الأموال، كما قال تعالى في الدُّيون: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283].
ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة، والعامة: مثل ردِّ الودائع، ومال الشريك، والموكِّل، والمُضارب، ومال المولَّى عليه من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصَدقات النساء وأجور المنافع، ونحو ذلك...
وإن كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قُبضت بحق؛ ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العَارِية([1])، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال في خطبته: (العارية مؤدّاة، والمنحة مردودة، والدين مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).
وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما: أن يؤدي إلى الآخر ما يجبُ أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان، ونوابه في العطاء أن يُؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جُباة الأموال -كأهل الديوان- أن يؤدّوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق" انتهى.
الثانية: يجب قسم الأموال بالعدل
ويجب على ولاة الأمور أن يقسموا المال بين الناس بالعدل، وبما يحقق المصلحة العامة والخاصة، ولا يجوز لهم أن يقسموها بالهوى والتشهي كما يقسم الشخص ماله الخاص، حيث له الحرية في توزيع ماله على من يشاء إن لم يكن فيه حرمة بتبذير أو إسراف؛ وذلك لأن ولاة الأمور هم أمناء ووكلاء وليسوا مُلَّاكاً للأموال.
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية" (ص: 26):" وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا مُلاَّكا؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني -والله- لا أعطي أحداً، وَلَا أَمْنَعُ أَحَداً؛ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حيث أمرت) رواه البخاري ...
فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله، يقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره الله تعالى" انتهى.
الثالثة: والقسم بالعدل يكون بالابتداء بالأهم فالأهم
المصارف المالية ينظر فيها إلى الأنفع فالأحوج، فيبدأ بمن لهم النفع العام المتعدي، ويترتب على وجودهم حماية بيضة المسلمين([2])، فيبدأ بالمجاهدين ودعمهم والإنفاق على أهلهم، ثم بمن يليهم وهكذا.
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية"(ص: 42): "وأما المصارف: فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة: كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. فمنهم المُقاتلة: الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم؛ حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص بهم، أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقاً، إلا ما خص به نوع، كالصدقات والمغنم.
ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم: كالولاة، والقضاة، والعلماء، والسعاة على المال: جمعاً، وحفظاً، وقسمة، ونحو ذلك؛ حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك.
وكذا صرفه في الأثمان والأجور، لما يعم نفعه: من سداد الثغور بالكراع، والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس: كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار.
ومن المستحقين: ذوو الحاجات؛ ... فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد؛ إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام:
الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.
الثاني: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا.
الثالث: من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم، كالجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناسحين ونحوهم.
الرابع: ذوو الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء متبرع، فقد أغنى الله به؛ وإلا أعطي ما يكفيه، أو قدر عمله.
وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضاً، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل، إلا كما يستحقه نظراؤه: مثل أن يكون شريكاً في غنيمة، أو ميراث.
ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى نفسه: من قرابة بينهما، أو مودة، ونحو ذلك؛ فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية ... المغني، والمساخر، ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم" انتهى.
الرابعة: والأموال يجب فيها الحكم بالعدل
فالحكم يكون بالعدل، كما قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58].
قال شيخ الإسلام في " السياسة الشرعية" (ص: 124):" وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة، على ما جاء به الكتاب والسنة...
وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به.
فمن العدل فيها ما هو ظاهرٌ يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.
ومنه ما هو خفي، جاءت به الشرائع أو شريعتنا- أهل الإسلام- فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل، والنهي عن الظلم: دِقِّه وجُله، مثل أكل المال بالباطل، وجنسه من الربا والميسر، وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل بيع الغرر ... وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى، ... وبيع الثمر قبل بُدو صلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة" انتهى.
الخامسة: الظلم في المال يكون من الولاة والرعية، بأخذ ما لا يحلُّ، ومنع ما يجب
والظلم حاصل من الطرفين الولاة والرعية، فتمنع الولاة ما يستحقه الناس من بيت المال، ويأخذون ما لا يحل لهم من المكوس والرشوة، وأما الرعية فيمنعون ما يجب من الزكوات والصدقات، ويأخذون مالا يحل لهم من بيت المال.
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية"(ص: 36): "وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون.
وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه.
وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد يُترك منها ما يباح أو يجب؛ وقد يُفعل ما لا يحل.
والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال، يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة، أو مضاربة، أو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم، أو مال وقف، أو مال لبيت المال؛ أو عنده دين وهو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين، أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه؛ فإنه يستحق العقوبة، حتى يظهر المال، أو يدل على موضعه.
فإذا عرَّف المال، وصُيِّر في الحبس، فإنه يُستوفى الحق من المال، ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء، ضُرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه.
وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روى عمرو ابن الشريد عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضَه وعُقوبَته)([3])رواه أهل السنن.
وقال صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الغني ظُلم)([4])أخرجاه في الصحيحين...
والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرماً، أو ترك واجباً، استحق العقوبة، فإن لم تكن مُقدَّرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقَب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عُوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم رضي الله عنهم ولا أعلم فيه خلافاً" انتهى.
السادسة: العطاءُ منوطٌ بالمصلحة
تصرفات الولاة منوطةٌ بالمصلحة، فيجب أن يكون عطاؤه المالي منوط بمصلحة الإسلام والمسلمين، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم عطاءً كبيراً حتى وجد بعض الصحابة في أنفسهم، وكان هذا العطاء لأمرين:
الأول: لمصلحة الإسلام والمسلمين من باب ترغيب دخولهم في الإسلام فيدخل بدخولهم الإسلام العدد الكبير من أتباعهم، أو يدفع بهم شر كبير عن الإسلام والمسلمين.
الثاني: يعطى لمصلحة نفسه حتى لا يكبه الله في النار بردته عن الإسلام كما في الحديث.
وأهل البدع والانحراف لا ينظرون في العطاء إلى المصلحة العامة، وإنما ضاق نظرهم فظنوا أنَّ هذا من باب المحاباة والتقسيم غير العادل، فلذلك قال شيخهم الأول: "والله إن هذه لَقِسمَة ما عُدِلَ فيها، ولا أُرِيدَ فيها وجهُ الله".
فهم يطعنون في الظاهر والباطن، فيطعنون في القسمة بأنها ظلم، ويطعنون بالنيات أنها لم يرد بها وجه الله.
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية"(ص: 43-46): "لكن يجوز -بل يجب- الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم، وعُيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن عُلاثَة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء: كصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وعدد كثير...
والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم.
فالكافر: إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسلامه؛ أر دفع مضرته، إذا لم يندفع إلا بذلك.
والمسلم المطاع يُرجى بعطيته المنفعة أيضاً، كحسن إسلامه، أو إسلام نظيره، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في العدو، أو كف ضرره عن المسلمين، إذا لم ينكف إلا بذلك.
وهذا النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، كما يفعل الملوك؛ فالأعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله، كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد، كان من جنس عطاء فرعون؛ وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم، ومحو اسمه، وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة" انتهى.
السابعة: رعايةُ الخلق بالجود والنجدة
لا تكمل السياسة إلا باقتران الصفات وتكاملها، وههنا في باب العطاء السماحة والشجاعة.
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية" (ص: 46-50): "فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود، الذي هو العطاء؛ والنجدة، التي هي الشجاعة؛ بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الأمر، ونقله إلى غيره...
ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها؛ فصاروا نهّابين وهّابين، وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه؛ إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في، عاجل دنياهم، وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة، إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها.
وفريق عندهم خوف من الله تعالى، ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحاً من ظلم الخلق، وفعل المحارم، فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، فيمتنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل، أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب، يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب، يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين.
وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل؛ لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا، ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه، ولا يعطي غيره، ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار؛ لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم.
الفريق الثالث: الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس -وإن كانوا رؤساء- بحسب الحاجة، إلى صلاح الأحوال، ولإقامة الدين، والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه فيجمعون بين التقوى والإحسان {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل: 128].
ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة. وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه، تطمع فيه النفوس، ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في ديتهم ما لا يصلحون بالثاني؛ فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين.
وهذا الذي ذكرناه في الرزق، والعطاء، الذي هو السخاء، وبذل المنافع، نظيره في الصبر والغضب، الذي هو الشجاعة ودفع المضار. فإن الناس ثلاثة أقسام:
قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث -هو الوسط- الذي يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ: خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا دَابَّةً، وَلَا شَيْئًا قَطُّ، إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ، إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا اُنْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى ينتقم لله).
فأما من يغضبه لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره. فهذا القسم الرابع، شر الخلق؛ لا يصلح بهم دين ولا دنيا.
كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حقوقهم، وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور. وكل ما كان إليها أقرب، كان أفضل" انتهى.
الثامنة: ما يُؤخذ بسبب الوظيفة فهو حرام
وقد بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان بنقل الحكم مع التعليل وهذا من أحسن الجواب.
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية" (ص: 37): "وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم؛ كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل.
وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي، رضي الله عنه، قال: (اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إلَيَّ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا اللَّهُ؛ فَيَقُولُ: هَذَا لكم، وهذا أهدي إلي؟ فهلا جلس فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ. فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، إلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ؛ إنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رأينا عفرتي إبطيه؛ ثم قال: اللهم هلبلغت؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثًا).
وكذلك مُحاباة الولاة في المعاملة من المبايعة، والمؤاجرة والمضاربة، والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين، لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خُصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدل، يقسم بالسوية" انتهى.
التاسعة: التورُّع الفاسد في الولايات المالية
يجب التعاون مع الجميع على البر والتقوى ولو كانوا من الظالمين، والتعاون في تخفيف الظلم ومن قام بهذا فهو وكيل للمظلوم لا للظالم، وكثير من الناس من يتورع في قضية الإعانة ومنع الظلم بالورع الفاسد الذي حقيقته الجبن والبخل.
قال شيخ الإسلام في" السياسة الشرعية" (ص: 39-41): " ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على ظلم؛ فإن التعاون نوعان: الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهاد وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين؛ فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضاً على الأعيان، أو على الكفاية متوهما أنه متورع.
وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إذ كل منهما كف وإمساك.
والثاني: تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك؛ فهذا الذي حرمه الله ورسوله.
نعم إذا كانت الأموال قد أُخذت بغير حق، وقد تعذَّر ردُّها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور، ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال -إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم، ولا على ورثتهم -أن يصرفها- مع التوبة إن كان هو الظالم- إلى مصالح المسلمين.
هذا هو قول جمهور العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية، كما هو منصوص في موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذها، فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها: كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها، وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] المُفسِّر لقوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: 102] ؛ وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما: هو المشروع.
والمُعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم؛ لا وكيل الظالم؛ بمنزلة الذي يقرضه، أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم.
مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه، أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع؛ فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض، ودفع ما يطلب منهم؛ لا يتوكل للظالمين في الأخذ.
وكذلك لو وُضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم، من غير محاباة لنفسه ولا لغيره، ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم، والإعطاء كان محسناً؛ لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابياً مرتشياً مخفراً لمن يريد، وآخذا ممن يريد.
وهذا من أكبر الظلمة، الذين يُحشرون في توابيت من نار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار" انتهى.
العاشرة: مصادر الأموال السلطانية
قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية" (ص: 28): "الأموالُ السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة؛ ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء".
وهذا يؤكد أن أكثر رزق هذه الأمة هو من الجهاد في سبيل الله وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ، وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ).
رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية،،
والحمد لله رب العالمين