


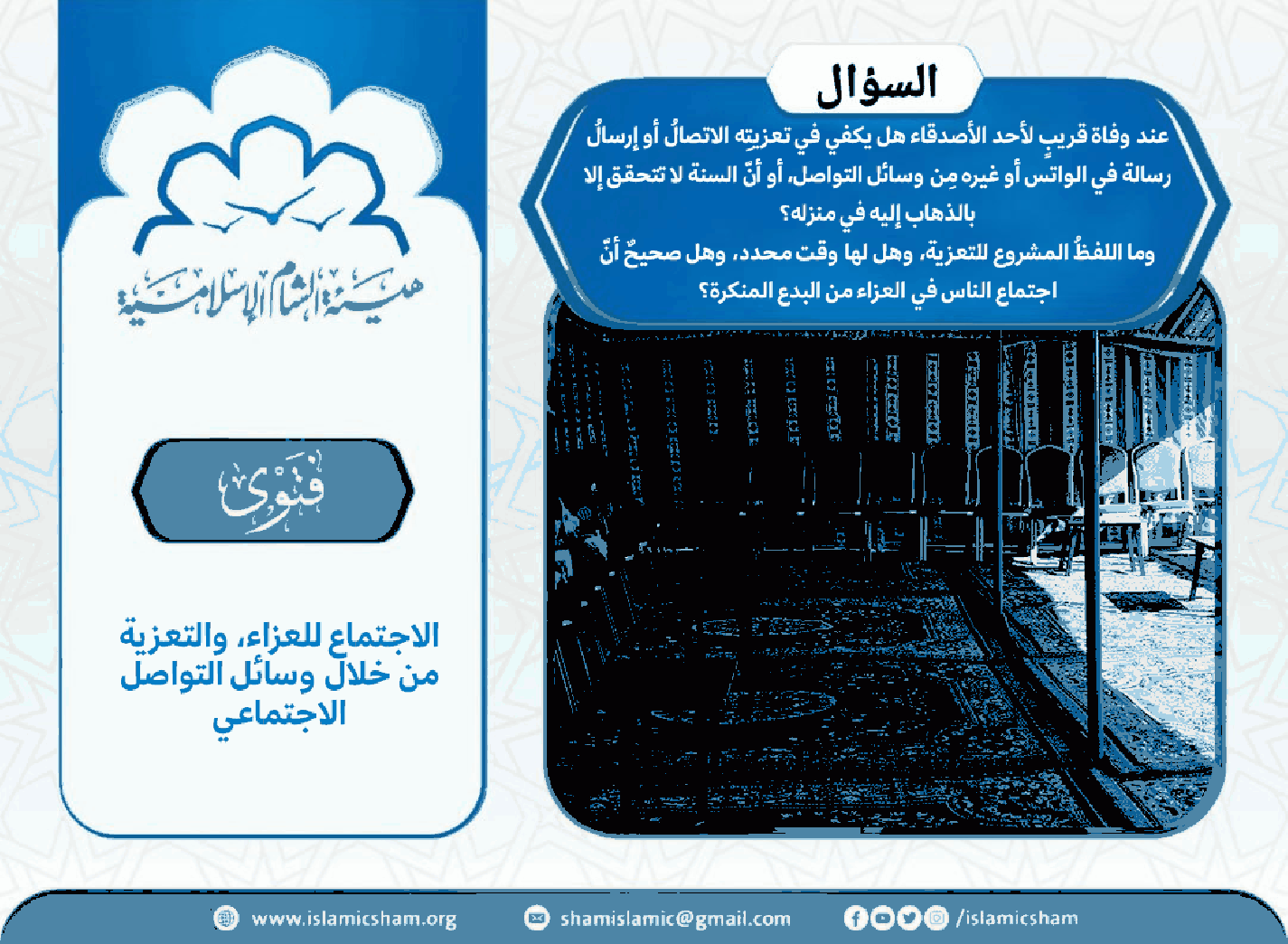





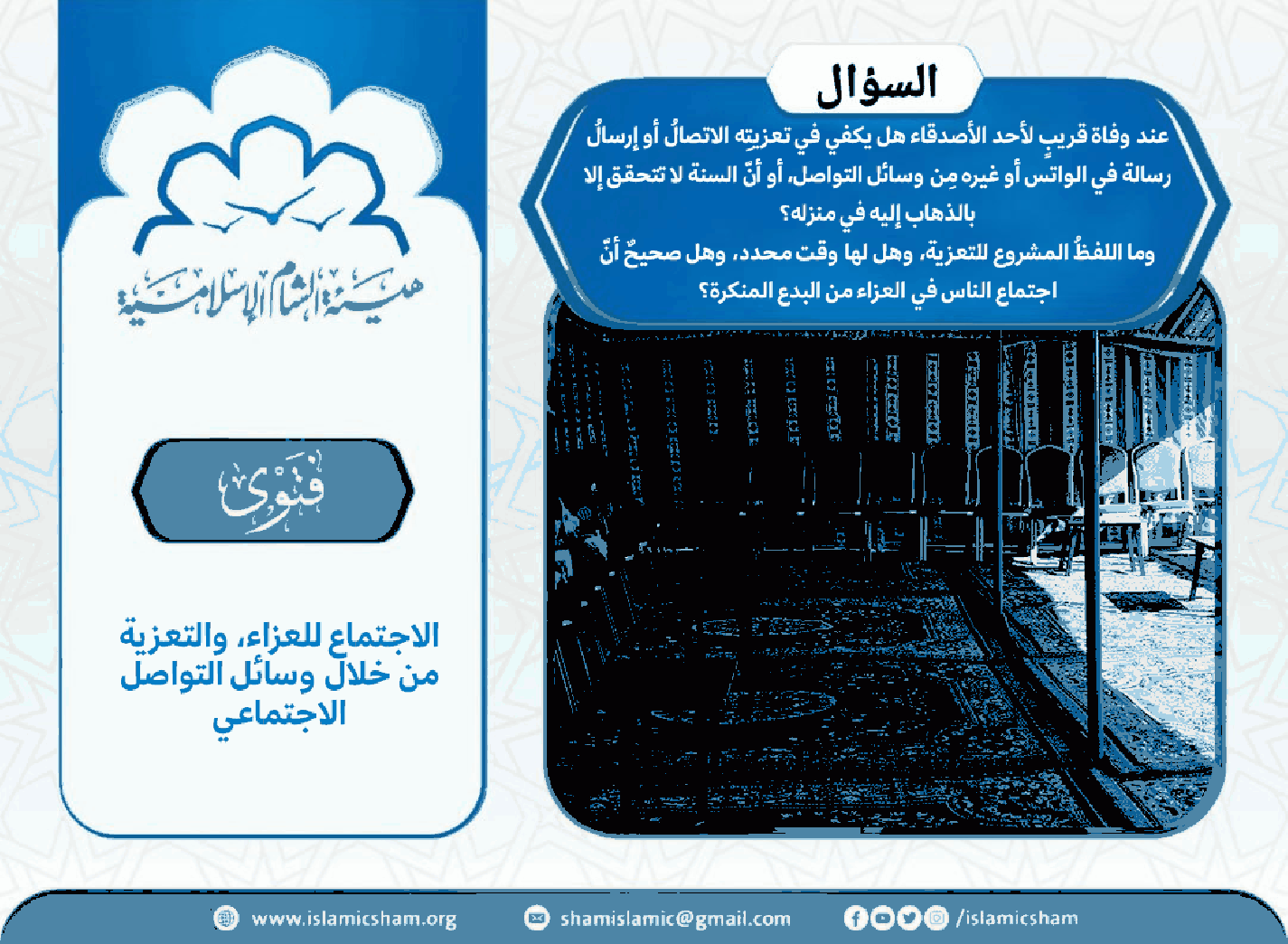



تبقى العاطفة الصادقة دوماً هي المحرك الرئيس للإنسان نحو أي عمل، فلولاها لأتى الأداء فاتراً، و هي التي تشعرنا باللذة أثناء هذا الأداء، و قد تُشكّل في نفس الوقت حاجزاً نفسياً بيننا و بين هذا العمل، هذا عند الشعور بالكره و عدم التقبل و الانسجام مع لون معين من ألوان الأداء.
و الاحتكام إلى العاطفة دوماً في أن نؤدي أو لا نؤدي قد لا يؤمن سلامة المسير (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ)، هنا يأتي دور العقل، إن لم يكن بقناعة ذاتية من داخل الإنسان بأهمية التفويض إليه في النهاية فسيبقى الواحد منّا مضطرباً في قراراته؛ إذ إن الثبات من صفة العقل، و التغيّر هو ما يميّز العاطفة، و عند المسلم، الكل في النهاية يخضع للشرع مع ما يتيحه من مساحات معقولة تنطلق فيها عواطفنا، تلهب خيالاً يدفعنا نحو العمل و الإبداع، شريطة أن يُلجَم دوماً بلجام العقل لتحقيق أعلى قدر من الفائدة بأقل قدر من الجهد و الخسارة .
لهيب العواطف يُمتعك بسرعة النتائج، و لكنك قد لا تحمد العواقب.
و اعتدال حرارة العقل قد يؤخر ظهور النتائج، و لكنك نادراً ما تندم عند العواقب .
و لما التهبت حرارة العاطفة عند الفاروق -رضي الله عنه- طلب من الحبيب صلى الله عليه و سلم أن يأمر عباد بن بشر بقطع رأس النفاق، و هذا ما كان سيؤدي بالفعل إلى نتيجة سريعة في التخلص من ذلك المنافق و شروره، و لكن ماذا لو تحدث الصحابة أن الحبيب صلى الله عليه و سلم يقتل أصحابه، فما كان الكل على دراية بخبث و سوء طوية هذا المنافق، و هذا ما تجلت فيه الرؤية عن بعد عند الحبيب صلى الله عليه و سلم؛ إذ كان من الممكن فقدان عدد كبير من الصحابة نتيجة شكهم في المراد مما أشار به عمر لو نُفّذ، في حين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتوى ما أراده عمر، و مضى في تربية هذا الجيل.
كم يا ترى بلغ عدد الصحابة الذين أعز الله بهم الإسلام عندما مات هذا المنافق؟
و ما بين التهاب حرارة العاطفة، و اعتدالها عند هذا العقل الذي كرّمَ الله تعالى به الإنسان ينشأ، إن صح التعبير (فقه الموازنات)، به يسترشد المسلم في اختيار الأولويات، و الأهم فالمهم عند العمل لهذا الدين.
فإذا كان هناك موقع يُسب فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم، أو رسومات كاريكاتيرية تسيء إليه صلى الله عليه و سلم، فالعاطفة الصادقة لا تصبر على مثل هذا، و لا يغمض لها جفن، و لا تهدأ بحال، عندها ينصب الفكر كله في (التأكيد) على حتمية (الإغلاق)، و لكنه، و من دون اعتدال حرارة العقل قد لا يتوجه إلى (التأسيس) على أهمية (الانفتاح).
و التأسيس أولى من التوكيد، هذه قاعدة فقهية يمكن أن تخدمنا هنا، بمعنى أنه لو أكدنا على ضرورة إغلاق هذه المواقع و النوافذ الإعلامية، فهذا -و لا شك- شعور طيب يُحمد أهله، و سيلزمه جهد كبير، و وقت، و وسائل نشر.
و لكن، كم سيكسب أعداؤنا و يخططون و يؤسسون في فترة انشغالنا هذه؟ كمن يراك في أول درجات السلم، فيقذفك بحجر، فتتشاغل بمحاولة رفعه، دون أن تفكر في الالتفاف حوله، أو حتى القفز عليه و لو إلى حين. كم درجة سيصعدُها، و أنت ما زلت في محاولاتك الأولى؟
و لكن، ماذا لو فكرنا في التأسيس؟ مواقع تنشر الإسلام و الدعوة و تربي، و فضائيات، و جمعيات ترعى حقوق الفقراء و المعوزين و المطلقات و الأرامل في مجتمعاتنا، و اللاتي الكثير منهن لا مأوى لهن، و أيضاً تأسيس دور للأيتام تقوم على برامج تربوية فاعلة، لا على مجرد توفير الطعام و الشراب و الملبس لهم، والاهتمام بإصلاح وضع المرأة و الطفل و الشباب..... الخ.
لو تأملنا طويلاً النهج الذي سار عليه موسى عليه السلام، و فرعون لا يكف عن الهجوم عليه و اتهامه بالسحر و الجنون و التهديد بالسجن، و موسى عليه السلام يمضي قُدماً في بيان دعوته، لا يلتفت إلى اِدّعاءات فرعون، و لو أراد لفعل، بل و ينتقل مباشرة لمناقشة السحرة و بيان بطلان حجتهم.
و لا تجد في كتاب الله آية تحكي عن دفاع الحبيب صلى الله عليه و سلم عن نفسه، إن هي (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ)، و من ثم التربية و البناء.
لقد جرت عادة البشر على أن من يهاجمك، إذا أعرضت عنه -على الرغم من الألم الذي يكتنفك- و مضيت قُدماً في طريقك، فإنه حتماً سيُعرضُ عنك، لا سأماً منك، و إنما سيبحث لك عن وسيلة أخرى، و سيبقى مشغولاً بك، في الوقت الذي تحقق أنت فيه نجاحات تقوى و تستعصي مع الأيام على النيل منها.
و قد عبر عن ذلك عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- بقوله لمن توعّده أن يتفرغ له (إنك لفي شغل)، و من هنا أيضاً نفهم الحكمة من الدعاء الجميل (اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه).
أظن -و الله أعلم- أنه قد بات من المُتعيّن علينا أن نفقه كيف نُشغِلُ أعداءنا من حيث أرادوا أن يشغلونا (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ).